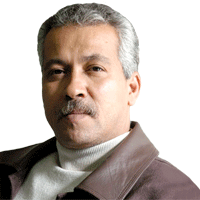من الشفاه إلى الشاشات.. الحكاية الخرافية تقاوم النسيان

انتقلت الحكاية الخرافية عبر الزمن لتتحول من مجرد كلمات مثيرة تتداولها الشفاه إلى قصص عن عوالم عجيبة تستعرضها الفنون، في مقدمتها المسرح والسينما، لكنها تتعدى كونها قصصا لتكون مرآة عن الثقافات والشعوب وتحاورها واختلافها، وهو ما تحاول الكاتبة الإيطالية مارينا وارنر تسليط الضوء عليه في كتابها “الحكاية الخرافية: مقدمة قصيرة جدّا”.
لا تزال خارطة الحكايات الخرافية تحتوي على زوايا غامضة وأراضٍ مجهولة، وتزداد يومًا بعد يوم حماسةُ الجماهير العريضة المختلفة لاكتشاف أسرارها. صُنفت على أنها أدب أطفال لفترة طويلة من تاريخها، إلا أنها اكتسبت مكانة جديدة وأصبحت مصدرًا للإلهام، لا في مجال الأدب وحده، وإنما في مجال الترفيه الجماعي الربحي. وتواصل أوجه التشابه، في الأفكار والبنية، في الربط بين الأدب القصصي الخيالي المعاصر والأساطير والخرافات القديمة. وتُعَد الحكايات الخرافية من أبرز وسائل التعبير التي تربط بين الماضي الزاخر بالخرافات والواقع الحالي، على نحو يشبه النسيج الضام الذي يربط أعضاء الجسم.
انطلاقا من هذه الرؤية تغوص الكاتبة الإيطالية مارينا وارنر في كتابها “الحكاية الخرافية: مقدمة قصيرة جدًّا” في أعماق هذا العالم العجيب، مستعرضة كنوزا من الروايات المبتكرة، وتسعى لتحديد ملامح هذا النوع الأدبي المتغير عبر الزمان. وبأمثلة من كلاسيكيات “ذات الرداء الأحمر” و”سندريلا” و”الجميلة النائمة” إلى معالجاتٍ عصرية مِثل “بياض الثلج” لديزني، تُقدِّم دفاعا قويّا عن الحكاية الخرافية باعتبارها منجما ثريا للفهم الإنساني ومرآةً ثقافية بالغة الأهمية.
سرد مألوف
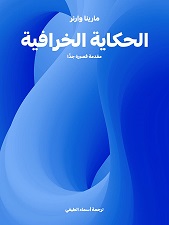
تتساءل وارنر في كتابها الذي ترجمته أسماء الطيفي وصدر عن مؤسسة هنداوي عن الخصائص المميِّزة للحكاية الخرافية؟ وتقول إن الخاصية الأولى هي السرد القصير، فالحكاية الخرافية غالبًا لا تتجاوز أحيانًا صفحة واحدة، وأحيانًا تطول قليلًا، ومع ذلك، لم تعد هذه الخاصية تنطبق بدقة على بعض الأعمال الحديثة التي تتخذ شكل الحكاية الخرافية، ولكنها تقارب الرواية في طولها، خلافًا لما كان شائعًا في الماضي. أما الخاصية الثانية فهي أن الحكايات الخرافية قصصٌ مألوفة، إما بسبب قدمها وانتقالها عبر الأجيال بالتواتر، وإما لتشابهها مع قصة أخرى يعرفها المستمع أو القارئ، فتبدو كأنها رُكبت ورُقِّعت من عناصر متفرقة، مثل صورة تقريبية للمجرمين تركب من ملامح مختلفة، فهذا النوع من الفن ينتمي إلى مجال التقاليد الشفهية الواسع.
وتُوصف حكايات خرافية كثيرة بأنها “حكايات شعبية” لتناقلها شفهيًّا ولأنها تُعتبر مجهولة المصدر وشعبية. ظهرت هذه الحكايات لا بين طبقة الأعيان المثقفين، وإنما بين غير المتعلمين، أو عامة الشعب. وقد أُودعت فيها حكمة الأجيال المتراكمة؛ على الأقل هذا هو الانطباع الذي تعطيه الحكايات الخرافية، أو الزعم الذي تقدمه منذ تأليف أُولَى المجموعات القصصية. ويميز الباحثون في مجال الحكايات الخرافية بين الحكايات الشعبية الأصلية وبين الحكايات الخرافية ذات الحس الأدبي أو الفني: فالأولى تتسم بجهالة مصدرها وعدم قابليتها للتأريخ عادةً، والثانية معروفة المصدر قابلة للتأريخ، لكن تاريخ تداول هذه القصص يعكس تداخلها بشكل غير قابل للفصل لكنه بنَّاء في الوقت نفسه.
وتوضح الكاتبة أن مع كل محاولات الفصل بين هذين النوعين استحالت الحكايات الخرافية إلى فن أدبي. ستسمع، على خشبة المسرح، أصداء التقاليد الشفهية القديمة في نص كلمات الأوبرا أو الحبكة: تدَّعي “بحيرة البجع” للموسيقي الروسي تشايكوفسكي، وأوبرا “روسالكا” للموسيقي الروسي دفوراك، والإنتاج الفني “طائر النار” لباليه روس، أنها تضرب بجذورها في التقاليد الشفهية مجهولة المصدر، مع أنها أعمال فريدة وأصلية. على نفس المنوال، تعلن السينما قربها من الحكايات الخرافية التقليدية، وتزعم في أحيان كثيرة بشكل ضمني أنها تستكمل الحكاية الخرافية بأكثر طريقة فعَّالة مُرضية، لتخلق تجربة سينمائية شاملة تجذب قطاعًا عريضًا من الجماهير. خُذ مثلا المسلسل التلفزيوني “الحكواتي” (1988). كتب هذا المسلسل وأخرجه أنطوني مينجيلا، وقام بدور محرِّك العرائس جيم هينسون، وتبدأ كل حلقة من حلقاته عند المدفأة، حيث يخلق الحكواتي ـ الذي يؤدي دوره جون هيرت ـ جوا دراميا للحكاية الخرافية التي سنشاهدها، ويقدمها كجزء من تقليد حي توارثته الأجيال عبر العصور.
وترى المؤلفة الإيطالية أن هذه المعالجات للحكاية الخرافية، هي في الحقيقة من أكثر المعالجات جرأة وإبداعًا بين تلك التي أُنتجت للتلفزيون على الإطلاق. ويختلف سرد الدرجة الثانية من هذا النوع، الذي لا يجد حرجًا في ادعاء وفائه للماضي، في جوهره عن المُثل الثقافية، في الأدب القصصي الخيالي وغيره من أشكال الإبداع، في مسألة التفرد والتجديد. أراد الأخَوان جريم نقل الصوت الحقيقي للشعب الألماني، من خلال تدوين الحكايات الخرافية من مصادرها الشفهية؛ وتظاهرا بالانسحاب وراء الستار في أعمالهما الأدبية. أما الروائية الإنجليزية أنجيلا كارتر (1941 – 1992)، فكان لها رأي آخر. أعلنت عن رغبتها في نسج حكايات جديدة من قماش الحكايات القديمة حتى تصل بها إلى عنان السماء، فقد كان القماش القديم ضروريًّا للوصول بإبداعها إلى ذروته.
السينما الوسيط الأشد تأثيرا في إعادة تشكيل الحكاية الخرافية في الوعي الحديث، خصوصا منذ بدايات القرن العشرين
وتتابع وارنر الخصائص المميزة للحكايات الخرافية وتشير إلى أن الخاصية الثالثة تنبع بشكل طبيعي من الطبيعة الشفهية والشعبية الضمنية للحكايات الخرافية، فصوت الماضي، الذي لا يمكن الاستغناء عنه، يُعرب عن نفسه من خلال تركيب وإعادة تركيب الحبكات والشخصيات والأدوات البلاغية والصور المألوفة، وقد تكون هذه العناصر ذات صلة بقصص معروفة للغاية مثل “الهر ذو الحذاء” أو “سندريلا”، لكن روح الحكايات الخرافية يُمكن تمييزها إجمالًا، وإن كانت تفاصيلها المحددة غير واضحة.
ويوفر عالم الحكايات الخرافية الإطار الذي يحيط بالأحداث الواقعة ضمن حدوده التي تكون صغيرة مثل البراعم، ثم تتفتح وتتحول إلى حكايات خرافية على النحو الذي نعرفه، منفصلة من ناحية السرد، ومترابطة من ناحية الإطار. وتُستخدم عبارة “الحكاية الخرافية” كثيرا كمجاز أو صفة في الأدب، فنقول: إطار خيالي يشبه الحكايات الخرافية أو نهاية على غرار نهايات الحكاية الخرافية، لوصف أعمال أدبية لا تنتمي إلى هذا النوع مباشرة، ولكنها تستعير رموزه ولغته. ويستخدم تعبير “الحكاية الخرافية” كما في بحث جوزيف أديسون الذي كتبه عام 1712 بعنوان “الكتابة بطريقة الحكايات الخرافية”، لاستحضار مشهد أو شخصية معينة، تتجاوز حدود الحكاية الخرافية كسرد فني مستقل.
وتمتاز عناصر الكثير من قصص الأطفال العبقرية، التي تعود للعصر الفيكتوري أو الإدواردي، باقتباسها شيئًا من روح الحكايات الخرافية: فلم يكتب تشارلز ديكنز وتشارلز كينجسلي وجورج إليوت وإديث نيسبت وجون رونالد تولكين حكايات خرافية بالمعنى الحرفي، لكنهم اقتبسوا عناصرها الشائعة وعالجوها ـ مثل البُسُط السحرية والخواتم السحرية والحيوانات الناطقة ـ من تقاليد الحكاية الخرافية، مما يزيد من استمتاع القرَّاء بالإحالة المباشرة، لتلك المعرفة المشتركة لشفرة الفانتازيا.
لغة رمزية

الخاصية الرابعة التي تتوقف عندها الكاتبة وارنر تتمثل في اللغة الرمزية للحكاية الخرافية “هي تتألف، بادئ ذي بدء، من أحداث مُتخيَّلة، تُنقل عَبر لغة رمزية عالمية مشتركة، وتشتمل لبناتها على شخصيات ذات أوصاف خاصة مثل زوجات الآباء والأميرات والأقزام والعمالقة، وأفكار رئيسية مُحددة متكررة مثل المفاتيح والتفاحات والمرايا والخواتم والعلجوم، وتستمد الرمزية حيويتها ومعناها من التباين الحاد في الصور والأحاسيس، مما يستحضر في الذهن تجارب حسية مباشرة، مثل البصر واللمس والحركة (الزجاج والغابات، الذهب والفضة، الألماس والياقوت، الشوك والسكاكين، الآبار والأنفاق). تصف الروائية والناقدة أنطونيا سوزان بيات ذلك ﺑ”قواعد السرد”، وتقول عن الأخوين جريم: الحكايات أقدم وأبسط وأعمق من أن تكون نتاج خيال فرد واحد. وإن المرء ليشعر بالغرابة عندما يتأمل حقيقة أن كل هؤلاء البشر، على اختلاف مجتمعاتهم القديمة والحديثة، كانوا بحاجة إلى قصص غير حقيقية. ويبدو أن سبب وجود هذه القصص السطحية، أنها سمة بشرية شائعة ودائمة، متجذرة في الطبيعة البشرية مثل اللغة واللعب.
وتلفت وارنر إلى أن الحكايات الخرافية تتسم بأنها أحادية البعد غير عميقة ولا معقدة أو مفصَّلة؛ تُسرد أحداثها مثلما تُسرد الحقائق البسيطة: فلا يثير وصف ذئب يلتهم فتاة، أو أمر طاهي القصر بطهي امرأة شابة أو تقطيع طفل لإعداد بودينج من الدماء، أيَّ احتجاج أو رعب في نفس الراوي. هذا حقيقة ما حدث، وهذه هي الحكاية دون زيادة أو نقصان. ولقد شجعت هذه السمة التقليدية لمستودع الحكايات الخرافية، الباحثين على إعداد أنظمة من شأنها تحديدها ووصفها.
وتولي الكاتبة اهتماما خاصا لدور النساء في نقل وصناعة الحكايات الخرافية، مشيرة إلى أن الكثير من الراويات كنّ نساءً من الطبقات الفقيرة أو نساء الأرستقراطية في بلاط القرن السابع عشر مثل ماري – كاثرين دادونيه. وتجادل بأن الحكاية كانت أيضا وسيلة النساء في التعبير عن الذات في مجتمعات أبوية.
وتركّز أيضا على موضوع التحول (Transformation) باعتباره لبّ الحكاية الخرافية. التحولات السحرية – من حيوانات إلى بشر، من فقر إلى غنى، من جهل إلى معرفة – تعكس رغبات داخلية وآمالا في التغيير. وتربطها بالتحولات النفسية والرمزية، وتوظف مفاهيم فرويد ويونغ لتفكيك تلك الدلالات.
وتشير وارنر إلى أن الحكاية الخرافية ليست بريئة، بل كثيرا ما عكست بنى السلطة، ومفاهيم الجندر، والتصورات الطبقية. مثلًا، قصص مثل “سندريلا” أو “الجميلة النائمة” تمجّد الامتثال والطاعة كمصدر للمكافأة، بينما تُصوَّر النساء المستقلات كشريرات (مثل الساحرة أو زوجة الأب).
علاقة فنية تكاملية

تحلل الكاتبة العلاقة العميقة والمتشابكة بين الحكاية الخرافية والفنون الأدائية والبصرية، وعلى رأسها المسرح والسينما، لا بوصفها علاقة تكميلية بل باعتبارها مسارات تأويلية تتجدد فيها الحكاية وتُعاد صياغتها بحسب تحولات الوعي والذوق. وترى أن الحكاية الخرافية منذ نشأتها احتفظت بطابعها الأدائي، فهي لا تُروى فقط بل تُجسّد، وهي تتكئ على عناصر التحول والسحر والمفارقة والصراع، وكلها مكونات درامية بطبيعتها. وفي سياقات المسرح الشعبي، كما في تقاليد الكوميديا ديلارتي أو المسرح الإنجليزي الكلاسيكي، وجدت الحكاية الخرافية بيئة مثالية لتعبير مباشر وحيّ عن المآزق الطبقية والجندرية، وكانت الشخصيات النمطية كالساحرة، والبطلة، والغول، تتحول إلى رموز لمخاوف حقيقية في حياة الجمهور. لكن المسرح المعاصر لم يكتف بنقل الحكاية، بل استخدمها كوسيط نقدي، حيث تحوّلت النصوص الخرافية إلى أدوات لكشف الأبنية الثقافية المتوارية، من خلال إعادة التمثيل أو قلب الأدوار أو فضح السلطوية الكامنة في منطق الحكاية التقليدي.
وتشير إلى أن السينما تعد الوسيط الأشد تأثيرًا في إعادة تشكيل الحكاية الخرافية في الوعي الحديث، خصوصًا منذ بدايات القرن العشرين. وتتوقف طويلاً عند تجربة والت ديزني، التي ترى أنها لم تكن مجرد اقتباس، بل عملية إعادة قولبة للحكاية بما يخدم تصورًا محافظًا عن النوع الاجتماعي والسلطة والهوية. في نسخ ديزني، تتحول الحكايات إلى سرديات نظيفة، تُقلم عناصرها العنيفة أو الجنسية، وتُطبع بطابع الطفولة والاستهلاك، فتصبح البطولة حكرًا على الأمير، وتُختزل المرأة في انتظار الخلاص، ويُختصر الصراع في شكل مبسّط يخدم نهاية سعيدة تُخدّر الواقع. ومع أن هذه النسخ خلّدت الحكايات في الذاكرة الجمعية، إلا أن وارنر تنبّه إلى الثمن الرمزي الذي دفعته تلك الحكايات حين فُصلت عن جذورها الاجتماعية وتحولت إلى بضائع بصرية.

وتحتفي وارنر بأفلام وسينمائيين أعادوا توظيف الحكاية الخرافية بوصفها أداة لتفكيك السلطة أو الغوص في اللاوعي. في أعمال مثل “الغرفة الدامية” لأنجيلا كارتر، أو أفلام جان كوكتو وتيري جيليام، نجد الحكاية وقد استعادت قدرتها على البوح، لكنها بوْح مقلوب، حيث لا تُروى لتسكين المخاوف بل لتفجيرها، ولا تقترح نهاية بل تفتح أسئلة. السينما، بفضل تقنياتها البصرية، منحت الحكاية بعدًا حلميًّا جديدًا، جعلها قادرة على تجسيد الانتقالات النفسية والتشوّهات المعنوية، وهو ما جعلها أداة مثالية لاختبار الهويات الممزقة ومساءلة الذاكرة الجمعية. ورغم التحولات التي طرأت على الحكاية الخرافية، تؤمن وارنر بأنها لا تزال تحتفظ بطاقة رمزية هائلة، تسمح لها بأن تعبر الأزمنة والأيديولوجيات، وتُستخدم في المسرح والسينما لا لتخدير الوعي، بل لتحفيزه. فالحكاية التي وُلدت من رحم الشفاهة والأسطورة لا تزال قادرة على البقاء حين تُعاد كتابتها وتمثيلها ضمن شروط العصر، لا كوثيقة تراثية، بل كخطاب حيّ يقاوم النسيان ويؤسس للمعنى من جديد.
وفي كل هذه التحولات، تبقى الحكاية الخرافية، في نظر وارنر، أكثر من مجرد قصة تُروى، إنها شكل تعبيري دائم الحركة، وسجلّ رمزي يحمل تناقضات الثقافة البشرية، يتبدل ويتقنّع، لكنه لا يزول، بل يعود في أشكال جديدة، على الخشبة أو على الشاشة، ليوقظ فينا ذلك الإحساس البدائي بالعجب، ويذكّرنا بأن كل سرد، مهما بدا بسيطا، يخفي تحته بنية عميقة من الرغبات والمخاوف والصراعات.