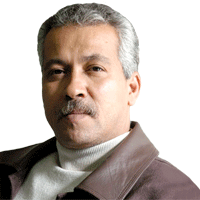محمد العدوي يكشف الجذور العميقة للهجات المصريين

اللهجات العامية ليست مجرد انحرافات لغوية عن الفصحى كما توهّم البعض، ولا هي بقايا مهملة من كلام الشارع، بل هي طبقات حيّة من التاريخ الشعبي، وشيفرات ثقافية تحفظ في طياتها بقايا التحولات ومسارات الامتزاج وأصداء الهويات العميقة. اللغة التي نتحدثها دون تفكير، تحمل في جوهرها ذاكرة طويلة: ذاكرة المزارعين والحرفيين، الأمهات والجدات، الرواة والمنشدين، من نحتوا حكاياتهم في الأغاني والأمثال والصلوات الشعبية.
في كتابه “التراث الشعبي: جذور اللهجات العامية المصرية”، ينظر الباحث محمد العدوي إلى العامية نظرة مغايرة، جادّة وعميقة، لا بوصفها لهجة، بل بوصفها مرآة حقيقية لهوية الجماعة المصرية. فالعامية ليست مجرد أداة تواصل يومي، بل وعاء تراثي يحفظ سرديات الجماعة، ويمزج بين أزمنة متعددة؛ من الفرعونية والقبطية إلى العربية وما بعدها. وهي بهذا تعكس خريطة التكوين السكاني والثقافي لمصر، وتدلّ على حجم التفاعل بين العرب الوافدين والشعوب التي سكنوها، كما تعكس الحراك الاجتماعي والمقاومة الخفية للغزاة الذين لم يستطيعوا فرض لغتهم على المصريين.
ويفتتح العدوي كتابه الصادر عن دار الأدهم بمجموعة من التساؤلات من بينها: لماذا يتغنى شعراء الربابة في مصر بأبطال من العصر الجاهلي مثل عنترة بن شداد والزير سالم وسيف بن ذي يزن؟ ولماذا تحتل السيرة الهلالية مكانة مركزية في التراث الشعبي المصري؟ لماذا جاء أبطال السير الشعبية من أبناء البادية مثل الأميرة ذات الهمة وحمزة البهلوان وسعد اليتيم؟ ولماذا يطلق على أهم الأولياء لقب السيد البدوي وشيخ العرب؟ لماذا يختلف نطق حروف القاف والجيم من منطقة إلى أخرى في مصر؟ لماذا انفردت لهجة القاهرة بمفردات خاصة بها؟ لماذا انتشرت اللغة العربية في المنطقة الصحراوية التي تضم العراق والشام وشمال أفريقيا وتوقفت عند حافة الصحراء ولم تنتشر مع انتشار الإسلام في بلاد فارس والأناضول وأفريقيا المدارية؟ لماذا اختفت حروف العين والحاء من اللغة القبطية رغم وجودها في الأسماء القديمة مثل رع وماعت وحتحور وخفرع وتوت عنخ آمون؟ متى ظهر لأول مرة باللغة العربية مصطلح “تاريخ المصريين” وماذا كان يعني وقتها؟ وكيف تطور معناه بمرور الزمن؟ وكيف تعربت مصر؟
وعاء تاريخي
ينطلق المؤلف من قناعة مؤسِّسة، تكاد تكون بمثابة أطروحة مركزية للكتاب، وهي أن اللغة العامية ليست انحرافًا عن الفصحى، ولا هي صورة مبتسرة منها، بل هي في جوهرها وعاء تاريخي لآثار لغوية وثقافية تعود إلى عصور ما قبل العربية. في هذا السياق يكشف أن الكثير من مفردات العامية المصرية اليوم تحمل أصداء اللغة المصرية القديمة، والقبطية، والنوبية، والآرامية، والعامية العربية، وبعض اللغات المتوسطية، لتصبح العامية مرآة لحضارات تعاقبت على مصر ولم تندثر، بل أعادت تشكيل ذاتها داخل اللسان اليومي البسيط للناس.
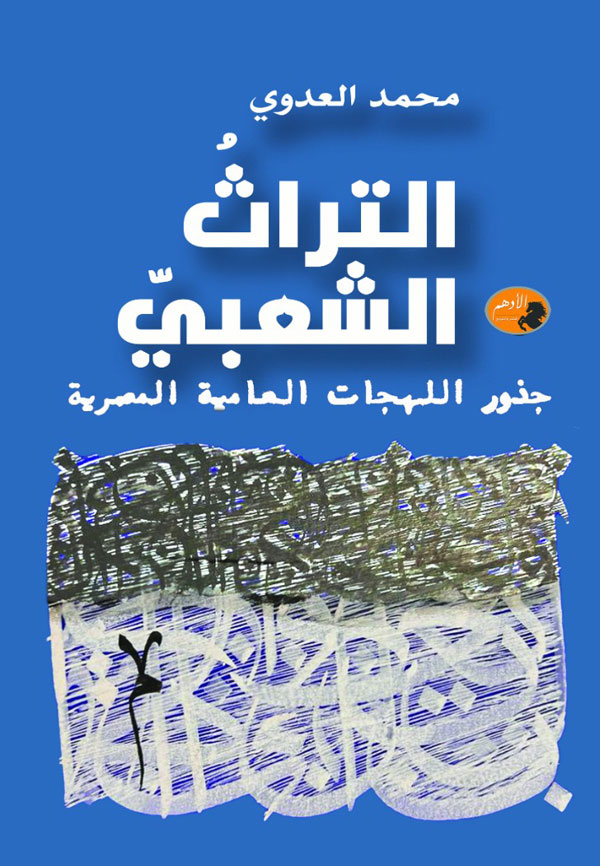
ما يميز هذا العمل هو قدرته على تجاوز النظرة الفولكلورية السطحية للتراث الشعبي، ليراه كجهاز معرفي يحمل منظومة من القيم والرؤى والخبرات التاريخية. لا تقتصر دراسة العدوي على الألفاظ والدلالات، بل تمتد إلى الأنساق الثقافية المضمرة في المأثورات الشعبية: الأمثال، الأغاني، الحكايات، الطقوس، والمعتقدات، ليؤكد أن العامية ليست مجرد لهجة، بل سجلّ لغوي أنثروبولوجي يحمل آثار الصراعات والتحولات التي عرفها المجتمع المصري عبر قرون.
من الأمثلة التي يتوقف عندها العدوي تحليل مفردات متداولة مثل: “كُسِر خُبزه”، أو “كَرْفَس”، أو “خِمْرِه”، موضحًا أن هذه الكلمات ليست ارتجالات شعبية، بل تحمل دلالات قديمة تعود إلى اللغة المصرية القديمة أو القبطية، وهي ما زالت تتردد على الألسنة، رغم تغير الأزمنة وتبدّل الأنظمة السياسية. ففي كلمة مثل “كرفس” يبيّن أنها مشتقة من الكلمة القبطية “كرفوس”، التي تعني النوع نفسه من النبات، وهو ما يعكس مدى صمود بعض المفردات في مواجهة التغير اللغوي، بفضل رسوخها في الممارسة اليومية.
ومن خلال رصد التحولات الصوتية والدلالية، يتتبع الكتاب كيف تحوّلت الحروف من الفصحى إلى العامية، وكيف حافظت بعض اللهجات على خصائص كانت موجودة في العربية القديمة، ما يجعل من العامية المصرية أشبه بـ”كبسولة زمنية” تحفظ أنماطًا لغوية عربية اندثرت في غيرها من البيئات. فهو يرى أن النطق الشعبي لحرف “الجيم” بصوت قريب من “چيم” فارسية في بعض مناطق الصعيد، أو استبدال القاف بالهمزة في القاهرة (“قال” تصبح “آل”)، ليس عبثًا صوتيًا بل له صلة بتاريخ الاستيطان العربي في هذه المناطق وتفاعله مع البنية الصوتية للغات السابقة.
ويركّز الكتاب على أن التراث الشعبي، في صوره المختلفة من أمثال وأغانٍ وحكايات وطقوس، لا يُمثل ترفًا فولكلوريًا، بل يحمل أنساقًا معرفية تعكس نظرة الناس إلى الحياة والموت والسلطة والعدالة والقدر. ويكشف العدوي كيف أن الطقوس والمعتقدات الشعبية تعيد إنتاج دلالات ورموز تنتمي إلى حضارات قديمة، لكنها صيغت بلغة دينية أو اجتماعية جديدة.
ويرى العدوي أن الأغاني الشعبية تمثل مرآة لما يمكن أن نسميه “العاطفة الجمعية”، وهي تُغنّى بلهجة الناس لا بلغة المثقفين، وتُعبّر عن نظرة المصري إلى الحب والموت والقدر والنجاة. ويلاحظ أن الكثير من الأغاني، خاصة تلك المرتبطة بالعمل، تحمل طابعًا سحريًا أو طقوسيًا، كأنها تعاويذ يُراد بها استحضار الحماية أو الرزق أو الخلاص.
ويلفت إلى أن هذه الأغاني كثيرًا ما تُصاغ بميزان خفيف لا يُخضعه لقواعد عروضية صارمة، لكنها تحتفظ بإيقاع داخلي منتظم ينبع من تكرار الكلمات أو الصور. كما يشير إلى حضور طيف من المعتقدات القديمة في أغاني الموالد والمناسبات، حيث يختلط الإسلامي بالموروث المصري الفرعوني والقبطي.
مرآة للخيال

ويقدّم العدوي الحكاية الشعبية بوصفها المرآة الأهم لخيال الشعب وتصوراته عن العدالة والمصير والمكر والبطولة. فالحكاية الشعبية، على عكس الأدب الرسمي، لا تُمجّد البطل النبيل وحده، بل تحتفي أيضًا بـ”المحتال الذكي”، أو “الضعيف الذي ينتصر بدهائه.” إنها تصور الحياة بوصفها معركة غير متكافئة، وتمنح المهمشين بطولات بديلة. يقول “في الحكاية الشعبية لا ينتصر الأقوى، بل الأذكى. ولا يُعاقب الفقير، بل يُكافأ لأنه ظلّ وفيًا لحنكته رغم حرمانه.”
ويتوقف العدوي مع الطقوس الشعبية مؤكدا أنها ليست “ممارسات قديمة”، بل هي تعبير حيوي عن حاجة الناس إلى النظام والمعنى في مواجهة الفوضى والقدر. فالطقوس تؤدي وظيفة مزدوجة: اجتماعية تقوم بتنظيم العلاقات داخل الجماعة، وسحرية رمزية تعيد التوازن بين الإنسان والقوى الغامضة (القدر، الموت، العين، الحسد).
ويشير إلى أن الطقوس المصرية كثيرًا ما تُدمج بين عناصر دينية ومجتمعية وسحرية. ففي طقوس الزواج مثلًا، نجد حضورًا قويًا لأغانٍ وتمائم وأطعمة ذات دلالات رمزية. أما طقوس العزاء فتحمل طبقات من الحزن الجمعي المشترك، وتُستدعى فيها أغانٍ وقصائد شعبية تؤدي وظيفة “التنفيس”. ويكشف أن بعض الطقوس تحمل أثرًا مباشرًا لمعتقدات مصرية قديمة، مثل: الاحتفال بـ”شم النسيم” باعتباره عيدًا مصريًا قديمًا، الاعتقاد في “السبع بنات” كرمز للخصوبة، أكل الأسماك المالحة في مناسبات معينة لطرد الأرواح الشريرة.
وفي فصل خصّصه لدراسة الأمثال الشعبية، يُظهر كيف أن المثل العامي المصري هو تلخيص لغوي محكم لفلسفة الحياة، وأن الكثير من هذه الأمثال تحمل مفاهيم العدالة والقدر والعمل والأخلاق والمكر، وكأنها تُعبّر عن نظرة فلسفية مركّبة طورها المجتمع في مواجهة سلطات القهر، أو طبيعة الحياة القاسية. ولا يفوته أن يُبرز الأثر الديني في هذه الأمثال.
◙ العامية ليست انحرافًا عن الفصحى، ولا هي صورة مبتسرة منها، بل هي وعاء تاريخي لآثار لغوية وثقافية
وينبّه المؤلف إلى أن العلاقة بين الفصحى والعامية هي علاقة مركّبة، اتسمت بالهيمنة والقمع اللغوي من جهة، وبالمقاومة والاستمرارية من جهة أخرى، إذ ظلت العامية تحيا في الفضاء الشعبي رغم سياسات التهميش. ويرى أن العامية المصرية تستحق الاعتراف بها بوصفها مكونًا أساسيًا من الهوية الثقافية، وأنها لغة حية، قادرة على التعبير والإبداع ونقل الوعي الجمعي، لا تقل شأنًا عن الفصحى، بل تكملها. ويشير إلى أن تهميش العامية لم يكن مجرد إهمال، بل نتاج سياسة لغوية تعيد إنتاج الهيمنة الثقافية باسم “النقاء”، بينما تُقصي اللهجات بوصفها “تشويشًا” أو “فسادًا لغويًا”، وهو ما يرفضه بحدة، معتبرًا أن العامية تاريخٌ حيٌّ لا يمكن محوه أو إلغاؤه دون أن نخسر جزءًا من ذاكرتنا الجماعية.
ويشير العدوي إلى أن البعض لا يريد تصديق حقيقة أن سكان الوطن العربي الحاليين ليسوا فقط من نسل القبائل العربية التي هاجرت مع الفتوحات، بل هم نتيجة تمازج شعبي وجيني وثقافي واسع النطاق بين العرب والسكان الأقدم في العراق والشام ومصر وشمال أفريقيا والسودان. يتعجبون من سرعة “تعريب” هذه المناطق وهيمنة اللغة العربية والثقافة العربية فيها، متناسين أن التاريخ المعاصر يقدم لهم نموذجًا أكثر وضوحًا، يتمثل في الاستيطان الأوروبي للعالم الجديد، حيث هاجر الأوروبيون بأعداد كبيرة، وتكاثروا، وفرضوا لغاتهم وثقافاتهم على السكان الأصليين حتى صار الهنود الحمر أقلية مهمشة في الولايات المتحدة.
لكن النموذج الأقرب لما حدث عندنا، هو ما جرى في أميركا الوسطى والجنوبية، حيث حدث اختلاط واسع النطاق بين المهاجرين الأوروبيين وسكان حضارات المايا والإنكا والأزتك، ونتجت عن ذلك هويات هجينة، لا تنفي الأصل الأوروبي ولا تقطع صلة الشعوب بتاريخها الأسبق، تمامًا كما حدث في العالم العربي. ومن يرفضون فكرة الهوية اللغوية بحجة أن سكان المكسيك لا يسمّون أنفسهم إسبانًا أو أن البرازيليين لا يسمّون أنفسهم برتغاليين، يتناسون أن هؤلاء السكان بالفعل ينحدرون من تلك الأصول، ولهذا ظهر مصطلح “أميركا اللاتينية”، ليصف المنطقة التي يغلب عليها الطابع اللغوي والثقافي للغزاة اللاتينيين.
ويضيف أن من يتغافلون عن حقيقة مشاركة العرب والقبط معًا في ثورة البشموريين، فإنهم يسقطون عمدًا القادة العرب الذين شاركوا في الثورة ضد العباسيين. ويشير إلى أن البشموريين أنفسهم قد لا يكونون مصريين خُلصًا، بل من بقايا الاستيطان اليوناني، بدليل أن لهجتهم القبطية لا تتضمن الحروف السبعة المضافة من الديموطيقية، فضلًا عن استعانة الخليفة المأمون ببطريرك أنطاكية السرياني لإقناعهم، ما يُشير إلى تمايز لغوي ومذهبي واضح. وفي المجمل، فإن التعريب كان اندماجًا حضاريًا لا إلغاءً للهويات السابقة، واللغة العامية ما هي إلا أثر حيّ على هذا التفاعل العميق، لا يمكن نفيه ولا اختزاله في سرديات قومية متعصبة أو رؤى شوفينية تقصي الآخر وتصطنع تاريخًا نقيًّا لا وجود له.