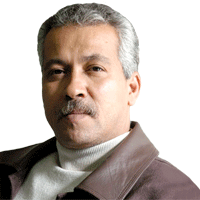علا الطوخي وأشرف صالح يقدمان عالم الغجر كما لم تروه الكتب ولا الشاشات

بين الأسطورة والحقيقة، تقف ثقافة الغجر على تخوم التاريخ والهوية، حاملةً على أكتافها أزمنةً من الترحال، والتهميش، والانبهار. قلة من الباحثين التفتوا بجدية أكاديمية إلى هذا الوجود الثقافي المختلف، المراوغ، المتعدد. وفي هذا السياق، تبرز جهود د. علا الطوخي ود. أشرف صالح. "العرب" التقت الباحثين في حوار مزدوج حول جهودهما البحثية عن الغجر.
يقدم الباحثان والأكاديميان علا الطوخي وأشرف صالح مشروعا بحثيا متكاملا حاول أن يستنطق الهوامش، ويعيد صياغة صورة الغجر خارج القوالب النمطية، لاسيما تلك التي رسختها الدراما والكتابات السطحية. وقد أصدرا أربعة كتب نوعية، تتوزع بين الجانب الأكاديمي والثقافي، تجسدت هذه الرحلة المشتركة في الكتب التالية: “الغجر في الدراسات العربية: دليل ببليوغرافي 1897 – 2024″، الذي يتتبع الإنتاج الفكري العربي عن الغجر عبر أكثر من قرن، “مجتمع الغجر: رحلة بين فصول التهميش”، الذي يحلل تهميش الغجر في المجتمعات العربية وعلاقتهم بالتراث الشعبي، “الغجر المهمشون: التاريخ والهوية”، وهو عمل استقصائي موسّع في نشأتهم وهويتهم وعاداتهم عبر العالم، وأخيرا “سيرة نساء الغجر: نسوة في المدن والقرى”، الذي يعيد الاعتبار للمرأة الغجرية من حيث دورها الاجتماعي والرمزي والاقتصادي.
في هذا الحوار المزدوج، يتحدث الباحثان عن خلفيات المشروع، ويقدمان قراءة تأملية في إشكالات الهوية الغجرية، ويكشفان عن تحديات الكتابة عنهم، من خرافة الساحرة المتجولة إلى واقع العرافة والتهميش، ومن حضورهم في معسكرات النازي إلى تجلياتهم في الدراما المصرية الحديثة.
خصوصية ثقافية
تقول علا الطوخي لـ"العرب" متحدثة بداية عن أزياء الغجر في مصر وما يميزها عن غيرها، حيث أوضحت أن الأزياء الغجرية تُعتبر بصفة عامة جزءًا من ثقافتهم وهويتهم، مُحمّلة بأكبر الطاقات الرمزية التي عليها إعلان الغموض والسحر، منقوشة بمعتقدات غائرة، تحمل ثقافتهم وأشياء من ثقافات أخرى مرّوا عليها، تحمل معاناتهم كما تحمل بهجتهم وأفراحهم، وكأنها لغة أخرى بينهم موحدة يتحدثون بها وتُعرّفهم.

وتوضح أن أزياءهم تتشكل بحسب احتياجاتهم وتقاليدهم وعاداتهم وحسب البلاد والشعوب المحيطة بهم. أما الحلي والزينة فتحتل المقام الأول في مكونات الزي الغجري في مصر والعالم؛ صنعوها وتحلّوا بها لتكسبهم مسحة جمالية فريدة من نوعها، ويُعتقد أنها بما تحويه من خشخشة ورنين ولمعان وبريق تصرف أعين الشر والأذى، وتقف درعًا ضد السحر والشؤم، وتمنح لهم روح الحياة والأمل. والأزياء الغجرية عامةً تمثل ثورة من الألوان، يلعب اللون دورا أساسيا في أزياء الغجر، إذ يُعدّ لغة يتحدثون بها. ويعتمدون في ملابسهم على استخدام الألوان الجريئة، الزاهية، والصاخبة، بمختلف تدرجاتها، مع المزج بين الألوان الصاخبة وتلك الدافئة.
وحول ما أشارت إليه الطوخي في كتبها من أن هناك أمرا غريبا عند الغجر يتمثل في احتفائهم بالأنثى واحتفالهم بمولدها والحزن عند إنجاب الأولاد، واختلاف هذا عن باقي العالم، تقول “احتفاء الغجر بالأنثى وحزنهم عند إنجاب الذكور هو أمر فريد من نوعه في بعض المجتمعات الغجرية، وهو عكس ما هو شائع في معظم الثقافات حول العالم. هذا الاختلاف له جذور اجتماعية واقتصادية وثقافية، وهو مرتبط بأسلوب حياتهم وطريقة تنظيمهم الاجتماعي. ففي المجتمعات الغجرية التقليدية، الفتيات لديهن الدور الاقتصادي الأساسي، حيث يشاركن في أعمال مثل: الرقص والغناء في الحفلات والمهرجانات والأسواق الشعبية، وقراءة الطالع والعرافة، وهي مهنة مربحة جدًا في بعض الثقافات، خاصةً في أوروبا الشرقية، إلى جانب التسوق والبيع المتجول.
في بعض المجتمعات الغجرية، خصوصًا في أوروبا الشرقية والبلقان، لا يزال هذا التقليد موجودا، لكن ليس بنفس الحدة كما كان في الماضي. مع تطور المجتمعات وتغير نمط الحياة، بدأ الغجر في تقبل إنجاب الذكور بشكل أكبر، خاصة مع تحسن فرص التعليم والعمل في بعض البلدان. في بعض الدول الغربية، تغيرت الأدوار الاقتصادية للمرأة، وأصبح الذكور يحصلون على فرص عمل في المهن اليدوية، مما خفف من الفجوة بين الجنسين داخل المجتمع الغجري”.
وفي ما يتعلق بتصدير الغجر في التسول والغناء، تؤكد الطوخي أن “تصدير صورة الغجر في التسول والغناء لم يكن عشوائيًا، بل له جذور تاريخية وثقافية وسياسية امتدت عصورا. هناك عدة عوامل أدت إلى انتشار هذه الصورة في الأذهان، منها التاريخية، الاقتصادية، الاجتماعية، بالإضافة إلى تأثير السينما والإعلام، وعدم حصول الغجر على فرص متساوية في سوق العمل”.
وتستدرك “لكن في الحقيقة الغجر مجتمع متنوع، ولديهم ثقافتهم ومهنهم التي تتعدى هذه الصورة النمطية. لديهم حرف يدوية مثل صناعة السكاكين والمجوهرات، وأعمال تجارية صغيرة مثل بيع الملابس المستعملة أو العمل في الأسواق الشعبية، وأدوار في المجتمع كعاملين في البناء والتجارة المتنقلة”.
وترى أن “تناول الدراما المصرية لشخصية الغجر في مسلسلي ‘نسل الأغراب’ و’جزيرة غمام’ جاء بشكل مختلف عن بعضه البعض، لكنه اتسم ببعض القوالب النمطية التي لطالما التصقت بالغجر في الأعمال الفنية، سواء المصرية أو العالمية. ‘نسل الأغراب’ (2021) قدم الغجر بشكل درامي شيق، لكنه لم يكن دقيقًا تاريخيًا أو اجتماعيًا، حيث ركز على الصورة النمطية للأسطورة أكثر من الواقع. و’جزيرة غمام’ (2022) قدم الغجر بصورة أكثر عمقًا من نسل الأغراب، لكنه لم يخرج عن الإطار المعتاد الذي يربطهم بالشر والفتنة داخل المجتمع. كان من الأفضل أن تُظهر الدراما جوانب أخرى من حياة الغجر، مثل ثقافتهم الفريدة، موسيقاهم، أعمالهم اليدوية، وأساليبهم في التعايش مع المجتمعات المختلفة، بدلًا من التركيز فقط على الجانب المظلم والأسطوري فيهم”.
انتشار الغجر

للمزيد من العمق في الرؤية حول هذا المشروع البحثي المتفرد للطوخي مع د.أشرف صالح، كان الحوار أيضًا معه. انطلاقا مما ذكره في كتابه من أن الغجر كان منهم نصف مليون في محرقة هتلر، يقول “كان الغجر من بين المجموعات التي استهدفتها المحرقة النازية (الهولوكوست) خلال الحرب العالمية الثانية (1939 – 1945). النازيون اعتبروا الغجر ‘عرقا دنيئا’ وغير مرغوب فيه وفقا لأيديولوجيتهم العرقية، مما أدى إلى اضطهادهم وقتلهم في إطار خطتهم لما سموه ‘التطهير العرقي’. يُقدَّر أن النازيين قتلوا ما بين 220.000 و500.000 غجري خلال الهولوكوست، وهو ما يمثل تقريبًا 25 في المئة إلى 50 في المئة من إجمالي عدد الغجر في أوروبا آنذاك”.
وحول انخراط الكثير من الغجر في أماكن مختلفة إذ أصبحوا تابعين للدول، وكيف تم حصر الغجر في هذه الأماكن، يوضح صالح “الغجر في الأصل شعوب رحالة متنقلة بين الدول الأوروبية، لكن على مر العصور، تعرضوا لعدة محاولات للسيطرة عليهم وإجبارهم على الاستقرار. الحكومات الأوروبية، سواء في العصور الوسطى أو الحديثة، استخدمت إستراتيجيات مختلفة لحصر الغجر داخل مناطق معينة وإجبارهم على الانخراط في المجتمعات المستقرة. حصر الغجر في أماكن معينة لم يكن دائمًا بمحض إرادتهم، بل كان نتيجة القوانين القسرية والاستعباد والاضطهاد التاريخي الذي تعرضوا له”.
◄ الباحثان علا الطوخي وأشرف صالح قدما مشروعا بحثيا متكاملا حاول أن يستنطق الهوامش، ويعيد صياغة صورة الغجر خارج القوالب النمطية
ويضيف “أصبح الكثير من الغجر مستقرين في مدن وقرى داخل رومانيا، هنغاريا، بلغاريا، فرنسا، إسبانيا، وإيطاليا، لكنهم ما زالوا يحتفظون بثقافتهم الخاصة. في بعض الدول، لا يزال الغجر يفضلون العيش في تجمعات خاصة بهم، رغم الضغوط السياسية والاجتماعية التي تدفعهم إلى الاندماج. وبعض الجماعات الغجرية تمارس التنقل، خصوصًا في فرنسا وإسبانيا، لكنهم يواجهون قيودًا قانونية وصعوبات في الحصول على تصاريح الإقامة”.
قضية السحر والشعوذة والعرافات، مهن اشتهر بها الغجريون… تسأل “العرب” صالح هل ما زالوا متمسكين بهذه الأمور حول العالم؟ يقول “الإجابة معقدة، لأن الأمر يختلف من مكان إلى آخر، حسب المجتمع والقوانين والتطورات الحديثة. في بعض الدول الأوروبية، يتم تقديم العرافة في صالونات خاصة مقابل المال. في دول مثل المكسيك والبرازيل، ما زال الغجر يمارسون العرافة بشكل علني في الأسواق والمهرجانات. في العالم العربي، انخفضت ممارسات الشعوذة بين الغجر لكنها لا تزال موجودة بشكل محدود، خاصة في المناطق الريفية”.
ويتابع “في مصر والمغرب، لم يعد الغجر يمارسون السحر بشكل علني كما في الماضي، لكن لا تزال هناك بعض الحالات التي تمارس قراءة الكف والفنجان، خاصةً في الأحياء الشعبية. العرافة وقراءة الطالع لا تزال منتشرة جدًا بين الغجر في رومانيا، بلغاريا، هنغاريا، خصوصًا عند النساء، ويتم تقديمها للسياح وحتى للسكان المحليين. اليوم، لم يعدّ السحر جزءًا أساسيًا من حياة الغجر، بل أصبح وسيلة للربح أو تراثًا تقليديًا عند البعض”.
ويشير صالح إلى أن “الغجر منتشرون في كل ربوع العالم، بدءًا من الهند ووصولًا إلى أوروبا، الشرق الأوسط، الأميركتين، وشمال أفريقيا. مع انتشارهم في هذه المناطق، تأثرت طقوسهم وتقاليدهم بالثقافات المحلية، لكنهم في المقابل احتفظوا ببعض العادات المميزة التي ظلت متجذرة في مجتمعاتهم. الموسيقى والغناء أصبحا مصدر رزق لهم في أوروبا وأميركا والعالم العربي. العرافة وقراءة الطالع استمرت بقوة في أوروبا وأميركا اللاتينية، لكن تراجعت في العالم العربي. التكيف مع القوانين أجبرهم على تغيير أسلوب حياتهم في بعض الأماكن، لكنهم حافظوا على هويتهم الثقافية حتى لو تغيرت بعض التفاصيل لتتناسب مع الثقافات المحلية التي عاشوا فيها”.