صلاح الدين أقرقر لـ"العرب": الجيل الجديد لا ينقصه الذكاء بل الثقة

يعرف المغرب حراكا هاما في كتابة الرواية، ولا أدل على ذلك من حضوره في الكثير من الجوائز الأدبية الدولية، وظهور تجارب مميزة تكتب بطرق مختلفة مسائلة الواقع والتاريخ بجرأة ولكن الأهم من ذلك بوعي حاد، ومن هؤلاء الكاتب المغربي صلاح الدين أقرقر، الذي كان لـ"العرب" معه هذا الحوار حول رؤاه الأدبية والثقافية وأهم أعماله الروائية.
صلاح الدين أقرقر ابن مدينة تارودانت المغربية، وأن تكون ابنا لتارودانت، كما يقول، يعني أن تولد في حضن مدينة تهيئك للكتابة منذ نعومة أناملك. هذه المدينة، بتاريخها العريق، وشوارعها المتاهية، وذاكرتها المنقوشة على أبوابها العتيقة، كانت أول كتاب قرأه. ويعتبر أن الحركية الثقافية التي تشهدها منطقته ليست مفاجئة، بل هي امتداد طبيعي لعمقها التاريخي والروحي.
ويضيف “الكتابة عندي ليست خيارا نخبويا، بل ضرورة وجودية. ولكي تستمر، تحتاج إلى قارئ صادق، إلى فضاء حر، إلى ناشر لا يرى في الكتاب مجرد منتج، بل شراكة فكرية. الإبداع لا يروى فقط بالموهبة، بل أيضا بالكرامة.”
الكتابة رسالة
الكاتب ليس ساحرا، لكنه يشعل شمعة في نفق مظلم، وقد تكون تلك الشعلة كافية كي يرى أحدهم طريقا آخر
دشن أقرقر مساره الأدبي برواية “وإذا الأحلام وئدت”، وهي رواية تتحدث عن الربيع العربي وعن المأساة. تسأله “العرب” هل يمكن أن نعتبر هذه الرواية تأريخا لتلك المرحلة؟ فيجيبنا “وإذا الأحلام وئدت لم تكن محاولة تأريخ بالمعنى الكرونولوجي البارد، بل كانت صرخة في وجه التاريخ ذاته. لم أكن مهتما بتوثيق أحداث، بل بكشف الجرح الذي خلفته. الرواية كانت مرآة مهشمة تعكس شظايا الحلم العربي حين اصطدم بجدار الاستبداد والانكسارات.”
ويتابع “لم أشأ أن أكون مؤرخا، بل شاهدا. والواقع، حين يصاغ روائيا، لا ينقل كما هو، بل يفكك، يساءل، ويعرى. أردت أن أظهر كيف كانت الأحلام بذورا قابلة للإنبات، لكنها وئدت قبل أن ترى الضوء، لا لشيء سوى لأنها كانت صادقة أكثر مما يحتمله الزيف السائد هنا وهنالك وفي العالم بأسره.”
روايته “ملاكان وشيطان” فيها الكثير من الرسائل التي حاول تمريرها للجميع. ويقر الكاتب بأن عمله هذا كان بمثابة عودة إلى جذور الإنسان المغربي، إلى القرى التي تغيب عن الخارطة الرسمية، لكنها حاضرة بقوة في خرائط الألم. هناك، حيث يولد الإنسان منسيا، كانت الحكايات تختبئ تحت التراب، تنتظر من يحفر ليخرجها.
ويواصل “كتبت هذه الرواية لأنني كنت مدينا لصوت الفلاح، للمرأة التي تعجن الصبر، للطفل الذي يسير حافيا وراء حلم يذوب تحت الشمس. نعم، أكتب أدبا مناضلا، لكن ليس شعاراتيا. أن تكتب عن المهمش، هذا فعل نضال. أن تمنح لغته صوتا، وتاريخه شكلا، هذا هو الأدب الحقيقي في نظري.”
يقول أحد النقاد إن الفن الحقيقي هو الذي يوثق الواقع الاجتماعي. في روايته “المشي في حقل الألغام” كتب أقرقر عن القهر الاجتماعي. تسأله “العرب” هل تعتبر الأدب قادرا على تغيير الواقع؟ فيجيبنا “الأدب ليس سلما لإنقاذ العالم، لكنه مرآة تفضح زيفه. حين كتبت ‘المشي في حقل الألغام’، لم أكن أبحث عن عزاء، بل عن صدمة. الأدب، حين يكون حقيقيا، لا يهدئ القارئ، بل يوقظه. نعم، لا أتوهم أن روايتي ستغير قوانين الجوع أو الاستبداد، لكني أؤمن بأن جملة واحدة قد تزرع الشك في وعي جامد. وهذا هو التغيير الحقيقي: زلزلة اليقين. الكاتب ليس ساحرا، لكنه يشعل شمعة في نفق مظلم، وقد تكون تلك الشعلة كافية كي يرى أحدهم طريقا آخر.”
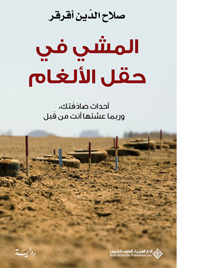
عنوان مثير تحمله رواية أقرقر الرابعة “زنزانستان”، وهو كما يقول الكاتب المغربي اسم بلاد متخيلة، لكنها مألوفة جدا. بلاد فيها كل شيء إلا الحرية. بلاد لا تقمع فيها الأجساد فقط، بل تجهض فيها الأحلام والأصوات.
ويضيف “العنوان لم يكن استفزازا مجانيا، بل توصيفا دقيقا لحالة شعوب تعيش في سجون بلا قضبان مرئية. الإنسان، حين يسلب حقه في الكلمة، يصبح رقما في أرشيف الطغيان. نعم، أردت أن أقول إن السجن لا يحتاج دائما إلى زنزانة. يكفي أن يمنع العقل من التفكير، واللسان من النطق، والقلب من الحلم.”
الشخصية الرئيسية في روايته “زنزانستان” هي سالم، وهو كاتب ويريد أن يقدِم على الانتحار. حول رمزية هذه الشخصية يقول صاحبها “سالم ليس مجرد شخصية روائية، إنه أنا وأنت وكل من يكتب في فضاء خانق. أردت أن أصرخ من خلاله: لسنا آلات تنتج نصوصا، نحن كائنات تنزف عبر الكتابة.”
ويشدد على أن “الإبداع حين لا يجد صدى، يتحول إلى لعنة. وسالم، هذا الكاتب الذي قرر أن يضع حدا لعزلته الداخلية، هو تجسيد لعجز المثقف أمام الجدار السميك للامبالاة. نعم، أردت أن أرد الاعتبار للفنان، لا بوصفه نبيا أو بطلا، بل ككائن هش، ينزف بصمت، ويمنح الآخرين بلسما قد لا يعود عليه بشيء.”
رواية “زنزانستان” صدرت في المغرب، لكن الروايات السابقة لأقرقر نشرت خارج المغرب، ويوضح ذلك بأن النشر في الخارج كان خيارا اضطراريا لا نخبويا. فهو في البداية، لم يبحث عن قارئ جديد بقدر ما بحث عن باب يفتح، مبينا أن دور النشر في الداخل، مع استثناءات مشرفة، تتعامل مع الكاتب الجديد كعبء، لا كإضافة. هناك غياب لثقافة المخاطرة، والمراهنة على الصوت المختلف.
ويواصل “الخارج قدم لي فرصة لأن يسمع صوتي، لكنني أصررت على أن تعود رواية ‘زنزانستان’ لتطبع هنا، كنوع من المصالحة مع الأرض التي أنجبتني، حتى لو كانت أحيانا طاردة.”
التاريخ والمستقبل

وصلت روايته “حاجب السلطان” إلى القائمة القصيرة لجائزة كتارا. حول هذا العمل يقول الكاتب “تغوص روايتي في مرحلة حرجة ومنسية من تاريخ المغرب، وهي حقبة ما قبل الحماية أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، زمن الانقسامات والمجاعات والصراعات على العرش، حيث انقسمت البلاد بين ‘بلاد المخزن’ و’بلاد السيبة’، وسط أطماع استعمارية أوروبية متزايدة.”
ويضيف “في هذا السياق المضطرب، ينطلق طالب سوسي من قرية تيوت نحو فاس، مدفوعا بنبوءة جده وسعيا لتحقيق مصيره. هناك، تمنحه المدينة فرصا عظيمة، لكنها تنقلب عليه لاحقا، فيجد نفسه وسط الفتن، ويقوده القدر لمواجهة مصيرية مع بوحمارة، الرجل الغامض الذي ادعى النسب الملكي وناهض السلطان مولاي عبدالعزيز، متهما إياه بالخيانة والانحراف عن الدين.”
ويؤكد أن هذه الرواية تطرح تساؤلا محوريا: هل سيتمكن الطالب السوسي من تحقيق حلمه في خضم هذا الزخم التاريخي، أم أن القدر سيقوده إلى مصير مغاير؟ وقد كان وصولها إلى قائمة كتارا القصيرة لحظة امتنان، لا غرور.
ويشدد أقرقر على أن الجوائز ليست غاية، لكنها تضفي على المسار بعض الإنصاف. الكاتب يعمل في العتمة، وإذا لم يشعل أحدهم شمعة في دربه، قد يظن أنه يسير وحيدا. لكن في النهاية، القيمة الحقيقية للعمل هي ما يتركه في قلب القارئ، لا على الرفوف.
الرواية التاريخية اليوم لم تعد تتغنى بالماضي، بل تحاكمه، تفكك أسطورته، وتنفض الغبار عن الحقائق الهشة
روايته الأخيرة “حاجب السلطان” هي رواية تاريخية. ومؤخرا نرى نوعا من الهجرة للكتاب إلى الرواية التاريخية. يعلق الكاتب المغربي “العودة إلى التاريخ ليست حنينا، بل مساءلة. نكتب التاريخ لا لنمجده، بل لنفضح ما تم دفنه فيه عمدا. الرواية التاريخية اليوم لم تعد تتغنى بالماضي، بل تحاكمه، تفكك أسطورته، وتنفض الغبار عن الحقائق الهشة.”
ويتابع “بالنسبة إلي، في رواية ‘حاجب السلطان’، لم أعد إلى التاريخ لمجرد إحيائه أو تمجيده، بل لأنني وجدت في إحدى حقبه المنسية، تلك التي سبقت الحماية، مرآة تعكس كثيرا من أزمتنا المعاصرة، خاصة ما يتعلق بانهيار الدولة، وتفكك السلطة، وصراع الطامعين، وتيه الشعوب بين الخوف والأمل. أعتقد أن العودة المتزايدة إلى الرواية التاريخية اليوم نابعة من رغبة مزدوجة: من جهة، هناك توق لإخراج المسكوت عنه من دهاليز النسيان، ومن جهة أخرى، حاجة إلى فهم الحاضر عبر تفكيك الرواية الرسمية للتاريخ، والتي كثيرا ما تمت صياغتها بأقلام المنتصرين أو بأوامر السلاطين.”
ويواصل “التاريخ، حين نرويه روائيا، نخضعه لعدسة الأدب: نسمح للشخصيات بأن تتكلم من داخل هشاشتها، وننقل الصراع من مستوى الوثيقة إلى مستوى المعنى. ولهذا، فإن ‘حاجب السلطان’ ليست مجرد قصة طالب سوسي في زمن بوحمارة، بل محاولة للتساؤل حول مصير الإنسان في زمن الفتن، وحول العلاقة المعقدة بين السلطة، والدين، والذاكرة.”
يعمل أقرقر في مجال التدريس منذ سنوات. هناك حديث كثير حول خطورة الجيل الجديد، وفساد أخلاقه وما إليه. ويقال أيضا إن المدرسة تخلت عن دور التربية، وكذلك الأسرة. تسأل “العرب” أقرقر بصفته أستاذا وقريبا من هذا الجيل، ماذا نحتاجه كي يكون هذا الجيل فاعلا في المجتمع لا مستهلكا فحسب؟ فيجيبنا “الجيل الجديد لا ينقصه الذكاء، بل الثقة. لا يحتاج إلى الوعظ، بل إلى من يصغي له دون إدانة مسبقة.”
ويضيف “نعم، هناك انهيار قيمي، لكننا ننسى أن هذا الجيل ولد في زمن هش، بلا قدوات، بلا رموز أخلاقية حقيقية. المدرسة لم تعد تربي، لأنها لم تعد تجد من يربي المدرس أولا. نحتاج إلى إعادة ترميم العلاقة مع المعنى: معنى الوطن، معنى الشرف، معنى الحرية. نحتاج إلى خطاب يخاطب العقل والوجدان، لا الخوف والخضوع. حين نعلّم أبناءنا كيف يحلمون، سيتعلمون كيف يبنون.”






















