"المطاريد" سرد ما بعد كولونيالي يكتب الهوية من الهامش

هناك أحداث تؤسس لحكايات مغايرة، من بينها فعل الطرد، المطرودون على مر التاريخ والأساطير كثيرون، بداية بآدم، مازال فعل طرد البشر ومحاولة اقتلاع جذورهم مؤسسا لسرد وقصص وأساطير كثيرة، إنه يشبه الفعل القادح لوجود مغاير. من هذا الفعل انطلق الروائي المصري عمار علي حسن في ثلاثيته الروائية "المطاريد".
رواية "ملحمة المطاريد" بأسفارها الثلاثة للمفكر والروائي المصري عمار علي حسن (الدار المصرية اللبنانية – 2025) ليست فقط نصا عن الخارجين على القانون أو المطرودين من المجتمع، بل هي ملحمة سردية تتجاوز الواقعة لتأسيس أسطورة الهامش، وتشكيل وعي جمعي مقاوم. ومن خلال رؤية مزدوجة ــ ثقافية وجمالية ــ ومن منظور ما بعد كولونيالي، تتبدّى الرواية بوصفها كتابة مضادة تعيد الاعتبار للمهمش، وتعيد تأويل المركز، وتستحضر “الطرد” كفعل تأسيسي لا كمجرد حادث عرضي.
الريف هنا ليس فضاءً جغرافيًا محايدًا، بل مجال للتسلّط الرمزي، وصراع الهويات، وإعادة إنتاج القمع عبر أدوات محلية تشكّل امتدادًا خفيًا لكولونيالية داخلية، تُمارسها السلطة الأبوية والدينية والعرفية. ومع ذلك، لا ينكفئ الهامش، بل ينتج سرديته الخاصة، ويحوّل النفي إلى ولادة جديدة، والنكبة إلى ذاكرة مقاوِمة.
الطرد طقس سردي
الرواية تعري بنية السلطة في مستوياتها المتعددة: القانون، العرف، القبيلة، الدين، وتكشف كيف تنتج السلطة المطرود وينتجها
يمكن استعارة عنوان “المطاريد” من المعجم الشعبي بوصفه وصفا سلبيًا يدل على الهارب المدان. لكنه في نسيج الرواية يتحوّل إلى مفهوم تأسيسي يُسائل شرعية المركز، ويمنح الخارج موقع الفعل. المطرود في هذا السياق يحمل رؤية مغايرة، فهو المنفي لأنه لم يخضع. هنا تتبدى إحدى آليات ما بعد الكولونيالية: قلب المركز على رأسه، وإعادة تموضع الهامش بوصفه مركزا بديلا للرؤية والتأويل، حيث يُعاد تموضع “الآخر” داخل الوطن ذاته، عبر قوى محلية تعيد إنتاج خطاب المستعمِر.
وفي المطاريد، تُجسَّد القرية كمستعمرة داخلية، والمطرود ليس خارجا على القانون، بل خارج على السردية الرسمية للهيمنة. هكذا يتحوّل المطرود إلى مثقف عضوي بالمعنى الغرامشي، وصاحب موقف سردي مناهض، يهدد توازن السلطة الرمزية، ويكشف زيف القوانين والعادات التي تخدم النخبة وتعيد إنتاج القمع باسم الطاعة والانضباط.
لا يبدأ النص من فعل سردي تقليدي، بل من لحظة الطرد التي تعيد تشكيل العالم وتمنح المطرود هوية مغايرة. “الطرد” هنا ليس عقوبة، بل أسطورة تأسيس تُروى شعائريًا، وتُحفر في الذاكرة الجمعية.
تتحول الرواية إلى طقس سردي يعيد سرد لحظة الأصل مرارًا، كل مرة من زاوية مختلفة، في محاكاة لأساطير السقوط والخروج الأول (خروج آدم من الجنة/ قتل قابيل لهابيل/ تمرد بروميثيوس). فكل طرد جديد يُعيد تشكيل الأسطورة ويغذي سردية مقاومة متوارثة، تؤسس للهوية الجماعية. ويصبح بمثابة بنية وجودية، تُقابِل الاستعباد، وتُنتِج خطابًا جديدًا عن الحرية والانعتاق. وبهذا، يتقاطع السرد مع الخطاب ما بعد الاستعماري الذي يرى في الطرد والنفي وسائل لاستكشاف الذات ومقاومة الكولونيالية الرمزية.
تتخطى بنية الرواية منطق الرواية الفردية إلى الملحمة الجماعية. فلا وجود لبطل أحادي، بل تتعدد الأصوات، وتتقاطع المصائر في نسيج سردي يحتفي بالجماعة المنفية، ويُعيد بناء التاريخ من أسفل. هذه البوليفونية ليست زينة أسلوبية، بل رؤية تفكيكية لمركزية السرد، حيث يتجاور الصوت الذكوري والأنثوي، الشعبي والصوفي، لتكوين سردية متشظية تحاكي واقعًا مفككًا. وهذا الانفتاح على التعدد هو بديل مضاد للنمط الكولونيالي الذي يسعى إلى توحيد الرؤية وتسطيح التجربة، وهذا التعدد السردي ليس تجريبا شكليا، بل تفكيك لسلطة الصوت الواحد، وكسر لهيمنة السردية الرسمية، حيث يصبح السرد نفسه أداة تحرر، ووسيلة لامتلاك الحكاية بعد أن سُلبت طويلا.

تعرّي الرواية بنية السلطة في مستوياتها المتعددة: القانون، العرف، القبيلة، الدين، وتكشف كيف تُنتج السلطة المطرود بوصفه جزءًا من آلية ضبطها للعالم. الأخطر من ذلك، أنها تُظهر كيف يعيد المطرود أحيانًا إنتاج السلطة داخل الهامش نفسه، وهو ما يجعل النص ينخرط في نقد ذاتي للهامش، ويتجنب فخ تمجيده أو تبرئته. هذا الوعي الحاد يعكس طابعا نقديا جذريا في تقاليد ما بعد الاستعمار.
تُجسّد الرواية ثلاثية القمع المحلي: الأب، الشيخ، والعمدة، بوصفهم وكلاء للسلطة، وامتدادات لبنية استعمارية خفية، تحكم وتُقصي، هنا يعاد إنتاج السلطة بتمثيلات محلية. ما يشبه “الاستشراق الداخلي” يحول الريف إلى خزان للخوف من “الآخر”، ويدين الخارج من المنظومة، لا لجرمه بل لعصيانه، وهو ما يعبّر عنه فانون بـ”عنصرية الذات ضد ذاتها”، أو ما يسميه هومي بابا بـ”التمثيل المشوَّه للتابع”.
تمتد ملحمة المطاريد على مدى خمسة قرون، مجسِّدة عبر ستة عشر جيلا سيرة الهوية في حال تحوُّل دائم، فنجد المطرود يتحول من رمز مقاوم إلى شبح منسي، ففي الجيل الأول، تتجلى الهوية بوصفها فعلا وجوديا مرتبطا بالرفض والكرامة والانتماء للمكان، غير أن هذا الجذر سرعان ما يبدأ في الذبول عبر الأجيال اللاحقة، حيث تتحول الهوية إلى ميراث رمزي أكثر منه مشروعا نضاليا، ويكشف هذا التطور عن تحول الهوية من الجذر إلى القناع: الجيل الأول: هوية مقاومة مرتبطة بالأرض، الأجيال الوسطى: بدء الانقطاع عن الجذر.
الجيل الأخير: تمويه كامل، انخراط في منظومة القمع حيث يتقنع الورثة بقناع السلطة ذاتها، ويتماهى الهامش مع المركز، في تحوّل يعكس ما يسميه هومي بابا “الهوية الهجينة”.
هكذا تكشف الرواية أن الهوية ليست ثابتة ولا مكتسبة نهائيًا، بل مشروع مفتوح على الفقد والانبعاث. فكل طرد جديد يعيد طرح سؤال الهوية: من نحن؟ ومن نكون إذا فقدنا جذورنا؟ بهذا، تصبح المطاريد سردية تحليلية لهوية تنمو، ثم تنكسر، وتُطمس، ثم تُستعاد بوصفها سؤالا مفتوحا لا إجابة نهائية له.
رغم أن الطرد يرتبط في المخيلة الجمعية بالذكورة، فإن الرواية تمنح المرأة فضاءً سرديًا فعّالًا. فالنساء في المطاريد يتعرضن للطرد تماما مثل الرجال، ويُشاركن في صياغة الحكاية. هذه الازدواجية في الطرد (النوعي والاجتماعي) تُنتج رؤية نقدية مزدوجة: تفكك المركز الذكوري، وتفكك سردية الطرد بوصفها تجربة ذكورية محضة.
الفضاء والذاكرة
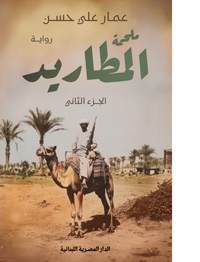
لغة الرواية تتحول إلى كائن حي، متعدد الطبقات: لغة حكائية، شعبية، صوفية، تراثية، شعرية. لا مجرد وسيلة بل موضوع جمالي وسياسي في آن، حيث تُفكك اللغة المركزية الرسمية، ويُمنح الهامش لغته ووعيه الخاص، هذا الصمت اللغوي قمعٌ رمزي، واللغة البديلة في الرواية فعل مقاومة.
الريف في الرواية ليس فضاءً واقعيا فحسب، ولا يُقدَّم كخلفية أو بيئة، بل كبنية مقاومة وسردية. فهو ميدان لإعادة بناء الهوية خارج سلطة المدينة/ القانون. مثلا: الجبل، الكهف، النهر، الغابة. كلها أماكن لجوء واستعادة وتكوين بديل. وهو ما يسميه باشلار بـ”الفضاء الممكن” الذي ينبت فيه الخيال المقاوم، في محاكاة لمفاهيم “ما بعد الاستعمار” في تفكيك الجغرافيا التي رسّختها السلطة أو الاستعمار. فلا مدينة حاضنة، بل ريف منسي يولد فيه الحلم، ويُكتب فيه تاريخ لا تعترف به السجلات الرسمية. بهذا، تنخرط الرواية في مشروع تأريخ بديل، يناقض المركزية الحضرية والسلطوية والاستعمارية معًا.
لا تسير الرواية وفق زمن خطي، بل تعتمد على الاسترجاع، والتكرار الشعائري، والتشظي الزمني، مما يعكس رؤية مضادة للتاريخ الرسمي.
هنا تُكتب الذاكرة لا كتوثيق بل كطقس مقاومة، والسرد يتحول إلى وسيلة إعادة بعث جماعي. وهذا ما يشكل جوهر المشروع السردي ما بعد الاستعماري: سرد ما لم يُكتب. والطرد لا يُقصي المطرود، بل يولّده سرديا. المطرود لا يندثر، بل يتحول إلى أغنية، تميمة، حكمة، أسطورة، بهذا، يتكرر الطرد ليعيد تشكيل الوعي، ويُصبح النفي طقسا كتابيا يؤسس للهُوية لا يفتتها.
وفي مقابل السرد الرسمي الذي يُقصي المطرودين من الذاكرة، تكتب المطاريد تأريخا بديلا من أسفل، من الحكاية الشفوية، من الأصوات المنسية. إنها رواية تُسائل من يملك الحكاية، ومن يُقصى منها، وتطرح سؤالا وجوديا عميقا: هل يمكن للكتابة أن تُعيد المطرود إلى نصّ الحياة؟
وأخيرا فإن ملحمة المطاريد عمل سردي مركب، يعبر الأجيال والطبقات اللغوية، ويُعيد كتابة الريف كذات منتجة للمعنى. إن الرواية تكتب من داخل الطرد، لا عنه، وتُعيد الاعتبار للهوية المهمشة بوصفها فاعلا سرديا وتاريخيا، وبهذا تثبت “ملحمة المطاريد” أنها واحدة من أهم الروايات التي تكتب من الهامش لا لتصفه، بل لتجعله مركزا بديلا لرؤية العالم، ولتعيد للتاريخ صوته، وللمنفي حقه في الحكاية.






















