هابرماس وهونيث يفككان أخطر الظواهر التي تهدد المجتمعات

بات جليا الانتشار الكبير لظواهر العنف، التي تعددت بين المادية وغير المادية، والتي صارت تحكم جل المجتمعات، ما يدعو لقراءتها قراءة تتجاوز الفهم السطحي والتناول المكرر والمتسرع، وهو ما قام به المفكران الألمانيان يورغن هابرماس وأكسل هونيث كل من زاويته.
يذهب المهاتما غاندي إلى أن سبب تفشي العنف في العالم هو عدم اكتشافنا أن مبدأ اللاعنف قوة يمتلكها الأقوياء وهي لا تقهر، كما لا يضيع أبداً تأثير حتى أونصة واحدة من قوة اللاعنف. أما ألفين توفلر يعتقد منذ ذلك اليوم الذي قذف فيه الإنسان القديم حيواناً صغيراً بحجر بدأ استخدام العنف لصنع الثروة. ويرى هربرت ماركيوز بدوره أن العنف منقوش في بنية مجتمعنا نفسه: إنه هو الذي يتراءى في العدوانية المتراكمة التي تهيمن على جميع نشاطات الرأسمالية الاحتكارية، في العدوان القانوني الذي يحدث على طرقنا الكبرى.
إذن العنف المجتمعي ظاهرة تنطوي تحتها أبعاد سياسية، وما العنف السياسي إلا إحدى الأدوات التي تستخدمها الشعوب للضغط على النظام السياسي المستبد في سبيل تحقيق أهدافهم المشروعة المتمثلة في القضاء على الظلم. وفيما يتعلق بالعنف الرمزي يعتقد بيير بورديو أن ما يصطلح عليه بالعنف الرمزي قد يأخذ شكل أفكار من شأنها أن تسيطر على ذهن الشخص وتستغله وتدفعه إلى المأساة، إن مختلف أشكال الهيمنة التي يخضع لها الناس، والتي توجه سلوكهم وأفكارهم وتحدد لهم اختياراتهم كلها تعبير عن عنف رمزي يمارس علينا دون بنادق أو خناجر، لكنه لا يقل عنها جرماً وألماً وعذاباً.
مفهوم العنف
تعد ظاهرة العنف عموماً من أقدم الظواهر التي عرفتها البشرية، وإن كانت قد تطورت وانتشرت في عصور أكثر من غيرها، وخصوصاً في الفترة المعاصرة، الأمر الذي يبعث على القلق ويستدعي التأمل فيها، لأنها حصيلة مجموعة من العوامل السياسية والاجتماعية والظروف الاقتصادية. وقد اتخذ العنف أشكالاً متعددة ومتنوعة عبر التاريخ، وقصة قابيل وهابيل هي أبرز مثال على ذلك، حيث شهدت الأرض آنذاك أول جريمة قتل عرفها التاريخ الإنساني تم استخدام العنف فيها.
يُعرف العنف لغوياً بأنه كل قول أو فعل ضد الرأفة والرفق واللين، وهو فعل يجسّد الطاقة أو القوة المادية في الإضرار المادي بشخص آخر، وهو أيضا “استخدام القوة وعدم الرفق، وفعل عنف يعني الخرق والتعدي، فنقول عَنّفَ أيّ خرق ولم يرفق، فهو عنيف إن لم يكن رفيقاً في أمره.”
أما اصطلاحياً هو كل سلوك عدواني يتّجه إلى الاستخدام غير الشرعي للقوة أو التهديد بهدف إلحاق الضرر بالغير، ويقترن العنف بالإكراه والتكليف والتقييد، وهو نقيض الرفق لأنه صورة من صور القوة المبذولة على نحو غير قانوني بهدف إخضاع طرف لإرادة طرف آخر.

ورغم تعدد العوامل المؤدية إلى العنف، إلا أن منطلقه الأساسي هو غريزة العدوانية المتفاوتة في قوتها بين إنسان وآخر، وهي غريزة يتأثر أسلوب التعبير عنها بظروف متعددة منها الثقافة السائدة، فمثلما أن العدوان غريزة، فإن الشعور الاجتماعي والضمير والإحساس بالذنب كذلك مشاعر فطرية لدى الفرد، وبالتالي فإن العنف لا يصدر عن فرد ما على الأغلب إلا وقد رافقته أفكار ومشاعر سلبية يستند إليها لتبرير اعتدائه. ومهما اختلفت الدوافع والوسائل والأهداف والنتائج، فإنها جميعها تشير إلى مضمون واحد وهو العنف الذي يهدف إلى إلحاق الأذى بالذات أو بالآخر.
يعرّفه أندريه لالاند في موسوعته الفلسفية بأنه “استعمال غير مشروع للقوة، من خلال فرض كائن ما نفسه على كائن آخر خلافاً لطبيعته دون وجه حق أو قانون.” أما موسوعة علم النفس فإنها تعرّف العنف بأنه “شكل متطرف من أشكال العدوان، مثل الاعتداء أو الاغتصاب أو القتل.”
هناك العديد من أسباب العنف بما في ذلك الإحباط، والتعرض لوسائل الإعلام العنيفة، والعنف في المنزل أو الحي، والميل إلى رؤية تصرفات الآخرين على أنها عدائية حتى وإن لم تكن كذلك. وفي معجم العلوم الاجتماعية يُعرّف العنف بأنه استخدام الضغط أو القوة استخداماً غير مشروع أو غير مطابق للقانون من شأنه التأثير على إرادة فرد ما. أما في معجم كامبردج لعلم الاجتماع، فجوهر العنف هو إلحاق ضرر جسدي أو إيذاء شخص لشخص آخر، وتشمل أشكال العنف حسب القاموس الضرب والاغتصاب والتعذيب والقتل…، وبطبيعة الحال تتمايز أشكال العنف هذه عن الأشكال غير المادية للسلطة الاجتماعية من إكراه أو قوة أو أيديولوجيا أو قوة اجتماعية، والعنف هو التعبير الأكثر تطرفاً عن القوة، باحتوائه على أقصى مكامن القوة الكلية، التدمير المادي لفاعل اجتماعي من طرف آخر، كما يمكن للعنف أن يكون تعبيراً عفوياً عن علاقات القوة.
وأهم ما يميز الفعل العنفي عند الإنسان هو القصد أو النية، وليس فقط ما يترتب عليه من آثار تدميرية، فمن الممكن أن نتحدث عن فعل مدمر يكون مصدره الحيوان أو الطبيعة، ولكنه عنف مجازي لا يحمل أيّ معنى في ذاته لأنه غير صادر عن نية وإرادة حرة… فالعنف يخص الإنسان بوصفه الكائن الوحيد الذي يتخذ لديه هذا السلوك شكل تصرف واعِ غايته إلحاق الأذى بالغير بأساليب مختلفة. وتكاد تُجمِع كل التعريفات على أن العنف هو كل عمل قاسٍ غير مشروع يؤذي الآخر، وهو سلوك له مبرراته يقوم على إقصاء الآخر وعدم الاعتراف بوجوده.
وفي النهاية يمكننا القول إن العنف (Violence) من وجهة نظر علم الاجتماع “هو كل سلوك يصدر عن فرد أو جماعة من الأفراد بقصد إيذاء الآخرين، لفظياً أو بدنياً أو مادياً، صريحاً أو ضمنياً، مباشراً أو غير مباشر، ناشطاً أو سلبياً، ويترتب على هذا السلوك إلحاق أذى بدني أو مادي أو نقص للشخص نفسه صاحب السلوك أو للآخرين.”
وقد اكتسب مفهوم العنف دلالات جديدة اليوم بارتباطه بالمعنى الحقوقي الحديث للكلمة وأصبح قريباً من معنى القوة والشدة. وهو ليس مجرد فعل إرادة بل يتطلب وجود شروط وظروف مسبقة وممارسة له ومن أهمها السلطة والقوة وأدواتها القمعية وتبريراتها الأيديولوجية التي تستمد منها شرعيتها.
إذن المشكلة ليس في وجود العنف في حد ذاته فهو موجود بوجود الإنسان، وإنما في اتساع مساحة ممارسات العنف وازدياد جرائم العنف، وهذه الزيادة، وهذا الاتساع قد اتخذا محورين: أولهما محور أفقي والثاني محور رأسي، والمحور الأفقي بمعنى اتساع مساحة ممارسات العنف داخل كل المؤسسات والوحدات الاجتماعية في المجتمع، داخل الأسرة، المدرسة، والمؤسسات التعليمية المختلفة وداخل وسائل الإعلام بكافة صنوفها، وداخل العمل والتجمعات السكانية ووسائل النقل والمواصلات. أما المقصود بالمحور الرأسي فهو ازدياد مساحة ممارسات العنف عبر المراحل العمرية التي يمر بها الإنسان منذ الطفولة مروراً بالمراهقة وحتى الكبر والكهولة، ويستوي في ذلك الذكور والإناث.
بذلك يعتبر العنف أشد الظواهر الاجتماعية ملازمة للاجتماع البشري، بل وأشدها غموضاً وأكثرها إثارةً للقلق، لما يخلقه من آثار سلبية على المستوى الفردي والمجتمعي بأسره، فالعنف ظاهرة لازمت مسيرة الشعوب وحياتها، على اختلاف درجات رقيها أو انحطاطها، وإن كانت بدرجات متفاوتة ووفق تمظهرات متعددة. ويعتبر سلوك مّا عنيفاً بناءً على الاعتبارات التالية:
1• سمات السلوك نفسه: هل هو هجوم جسمي أو أذلال أو تدمير ممتلكات بغض النظر عن آثار هذا السلوك على الشخص الذي يتلقاه.
2• حدة السلوك: هناك استجابات عالية الشدة مثل التحدث بصوت مرتفع، فيطلق على أصحابها أنهم عنيفون. أما الاستجابات منخفضة الشدة مثل التحدث بصوت منخفض فيطلق على أصحابها أفراد غير عنيفين.
3• تعبير الشخص المتلقي للعنف عن مقدار الألم والأذى الذي ألم به.
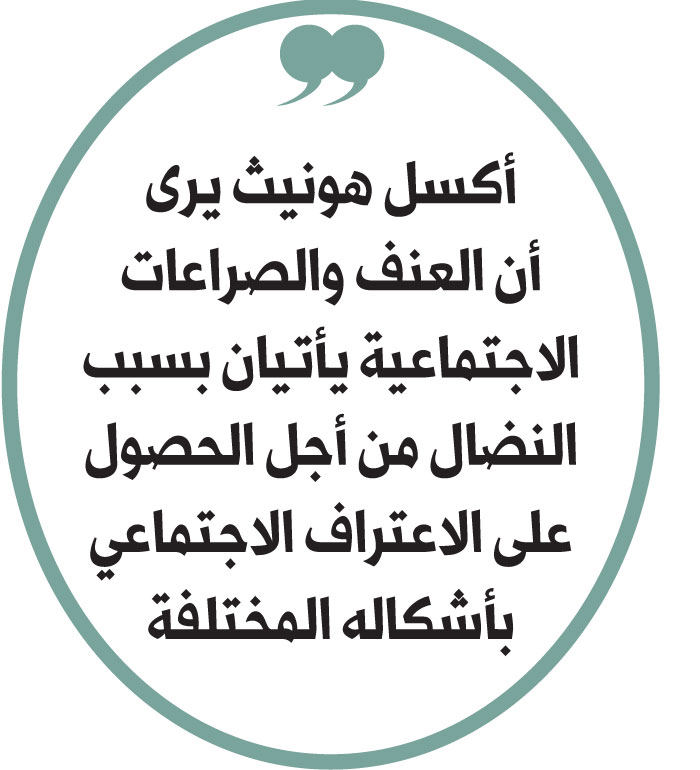
4• النوايا الظاهرة للشخص المعتدي.
5• سمات الملاحظ مثل جنسه ومركزه الاجتماعي والاقتصادي وخلفيته العرقية وتاريخ سلوك الفرد العدواني وغير العدواني.
6• سمات الفرد العدواني. وهكذا أصبحت جرائم العنف تحمل معها، خطورة الابتعاد عن الالتزام بروح الدين، وعدم اتباع أوامره، فضلاً عمّا تشكله هذه الجرائم من خلخلة في بنية المجتمع، وتفكيك في نسيج الأسرة الواحدة، وهو ما يتسبب عنه انزواء لثقافة التسامح، وتغييب لروح الحوار، حتى أصبح استخدام العنف الاجتماعي هو السبيل لحل الخلافات.
وفي النهاية يمكننا تعريف العنف المجتمعي: بأنه تعرض الشخص لتصرفات عنيفة في الأماكن العامة بصورة متعمدة وذلك من أشخاص لا تربطهم به صلة، ومن الأمثلة على العنف المجتمعي أعمال الشغب، وحرب العصابات، والبلطجة، والاعتداء بإطلاق النار من السيارات، والتطهير العرقي، والاعتداء الجنسي والحرب، كذلك يمكن تعريفه بأنه ممارسة بعض الأعمال بصورة متعمدة تجاه أفراد في المجتمع لإحداث ضرر جسدي أو نفسي. أو هو نوع من أنواع العنف يحدث في سياق المجتمع ويشمل التصرفات والأفعال التي تسبب أذى وضرراً للأفراد والمجتمع، وبشكل عام يتميز العنف المجتمعي بأنه يحدث بين الأفراد أو الجماعات في المجتمع، ويتسبب في خرق للقواعد الاجتماعية والقيم الأخلاقية. بمعنى أدق، العنف المجتمعي هو ظاهرة سلوكية مؤذية تقوم على إنكار الآخر، ويتم فيها استعمال العنف اللفظي أو الجسدي والاعتداء على الآخرين والتطاول على القانون من أجل تحقيق مصالح شخصية معينة.
العقلانية التواصلية
بناءً على ما تقدم سنحاول في هذه الدراسة استعراض تفسير نظريتي يورغن هابرماس وأكسل هونيث لمفهوم العنف المجتمعي. سعى الفيلسوف وعالم الاجتماع الألماني المعاصر يورغن هابرماس (1929) من خلال نظريته عن الفعل التواصلي إلى تحديد ملامح التعايش السلمي والاعتراف بالآخر بالاستناد إلى العقلانية التواصلية، التي تحكمها أخلاقيات المناقشة والحوار، التي ستفضي بطبيعة الحال – حسب التنظير الهابرماسي – إلى وضع الأسس العملية لممارسة الديمقراطية التواصلية، التي تعتبر المنطلق الأساسي لتجسيد مفهوم العيش المشترك مع الآخر والاعتراف به.
يستمد الفعل التواصلي عند هابرماس بواعثه من مفهوم العقلانية التواصلية، التي تمارسها “ذات قادرة على الكلام والفعل بهدف التوجّه نحو التفاهم بين الذوات،” ما يؤدي إلى عدم اللجوء إلى العنف أو إلى إلغاء الآخر والسيطرة عليه، وذلك بفضل قدرة الفعل التواصلي الذي يحدد العلاقات داخل مجالات عمومية قائمة على المناقشة والحوار متخذةً من المبادئ الأخلاقية أساساً لها، أطلق عليها هابرماس أخلاقيات المناقشة، التي تحكم العملية التواصلية حسب معايير متفق عليها.
ولكن تلك الأخلاقيات ليست مذهباً ولا نسقاً من القيم والمعايير الجامدة أو الثابتة، والدليل على ذلك، في أنه إذا تشكك أحد المشاركين في العملية التواصلية في الدقة المعيارية لتعبير مّا، أو إذا تعرضت أحد ادعاءات الصلاحية للشك، فإن ادعاءات الصلاحية نفسها تصبح موضع سؤال، وفي هذه الحالة لا بد للمشاركين في التواصل إعادة فحص تلك الادعاءات من جديد ومراجعتها مراجعة نقدية لتصحيح أخطائها.
وهكذا يعتمد هذا التفسير على البعد التواصلي اللغوي والتفاهم العقلاني الهادف، الذي يؤدي بالأطراف المشاركة في العملية التواصلية إلى محاولة تحقيق نوع من الاتفاق والإجماع المتبادل حول القضايا المطروحة للحوار، وفقاً لشروط وقواعد أخلاقية تنفي قهر الذوات أو السيطرة عليها أو خداعها ما يتيح لهم الفرص بالتساوي للمشاركة في الحوار والنقاش وصنع القرار، كما أن الإجماع لن يتم الوصول إليه إلا عن طريق قوة الأطروحة الأفضل، ما يؤسس لمفهوم التعايش السلمي والاعتراف بالآخر.
في ما يتعلق بمفهوم العنف المجتمعي قدم هابرماس تحليلاً عميقاً لمشكلة العنف المجتمعي من منظور فلسفي وسوسيولوجي، حيث اعتبر هابرماس أن العنف المجتمعي ليس مجرد فعل فردي أو اجتماعي عابر، بل هو ظاهرة معقدة تتأثر بالعديد من العوامل الثقافية، والسياسية، والاجتماعية.

ويرى هابرماس أن العنف المجتمعي هو نتيجة لفشل الحوار والتفاهم بين الأفراد والجماعات، فعندما تفشل الآليات السلمية لحل الخلافات، يلجأ الناس إلى العنف كوسيلة أخيرة للتعبير عن أنفسهم أو تحقيق أهدافهم. حيث تلعب السلطة والقوة دوراً أساسياً في نشوء العنف المجتمعي عندما تتركز السلطة في أيدي فئة قليلة، وتستخدم هذه السلطة بطريقة قمعية، فإن ذلك يخلق بيئة مواتية لممارسة العنف المجتمعي.
ويعتقد هابرماس أن غياب ترسيخ مبادئ الممارسات الديمقراطية بسبب القمع والاستبداد سيؤدي لا محالة إلى ممارسة العنف، حيث يعتبر أن الأنظمة الديمقراطية وبالأخص التواصلية (التشاورية) هي أفضل الأنظمة لمنع العنف، لأنها توفر إطاراً للحوار والتفاهم بين مختلف الأطراف المتنازعة من خلال المشاركة السياسية، ويمكن للمواطنين التعبير عن آرائهم ومصالحهم بطريقة سلمية.
وفي النهاية يؤكد هابرماس على دور الثقافة والأيديولوجيا في تشكيل ممارسات العنف، فالأفكار والمعتقدات السائدة في المجتمع يمكن أن تساهم في تبرير العنف وتشجيعه. وفي ما يتعلق بمفهوم الإرهاب قدم هابرماس تحليلاً خاصاً للعنف الإرهابي، وربطه بفشل الدول في تلبية احتياجات مواطنيها وحماية حقوقهم. كما ربط الإرهاب بالعنف الرمزي، حيث يستخدم الإرهابيون العنف للتعبير عن احتجاجهم على الظلم والاضطهاد.
ويرى هابرماس أن الحل الأمثل للقضاء على العنف المجتمعي بين أفراد المجتمع يتم من خلال التعايش والاعتراف بالآخر القائم على التفاهم والحوار المستمد من أسس العقلانية التواصلية. بمعنى آخر فإن العلاقات الإنسانية لا تقوم إلا على التفاهم والحوار العقلاني التواصلي. ومن هذا المنطلق يرى هابرماس أن أهداف القوى التقليدية القائمة على الإقصاء لا تتفق تماما مع أهداف العقلانية التواصلية، لأن الشخص العقلاني بالنسبة إلى هابرماس “هو الشخص الذي يحاول الوصول إلى اتفاق أو تفاهم عن طريق الحوار،” أي المبتعد عن العنف المادي وممارسته اللاإنسانية.
وهذا يعني أن اللغة والتواصل هما وسيلة أفراد المجتمع للوصول إلى اتفاق وإجماع مع الآخرين بهدف تجسيد التعايش؛ لأن الاتفاق الناتج عن العنف أو التأثير لا يمكن أن يعد اتفاقاً، بل يجب أن يعتمد الاتفاق فقط على الاقتناع الجماعي. وهكذا يصبح الحوار في سياقه الاجتماعي المستند إلى الفعل التواصلي وفق أخلاقيات المناقشة الهابرماسية عبارة عن أداة لإخراج المجتمع من الانعزال ويعتبر كذلك عنصراً لتحقيق الاندماج الاجتماعي بين أعضائه دون عنف ولا تطرف ويكمن دور الحوار في المجتمع بفتح باب المشاركة بين أعضائه في تحليل الأزمات التي يجتازها.
انطلاقاً ممّا سبق يمكننا القول بأن مشكلة العنف المجتمعي – حسب هابرماس – لا يمكن القضاء عليها إلا بواسطة التوافق أو التفاهم المتضمن للأفعال اللغوية للمشاركين في عملية التواصل، حيث أن عملية التواصل مشروطة بالأبعاد الاجتماعية والثقافية الخاصة بها، ولكنها تبقى أيضاً ذات طابع كوني، وعلى هذا الأساس، قدم هابرماس من خلال نظريته الفعل التواصلي القائمة على اللغة المبدأ المعياري الذي يعطي مكانة أساسية للجانب الاجتماعي في النظرية النقدية. بذلك يجعل هابرماس من الحوار موقفاً خيالياً، على حين كان ينبغي عليه أن يفهمه بوصفه هادياً إلى التقدم. ويصبح الحوار المثالي مرتبطاً بعالم مثالي عن “الحياة الطيبة” في مجتمع متحرر تحرراً أصيلاً. وما دام هذا العالم لم يوجد بعد، فالحوار المثالي مجرد انعكاس لنقيض الوضع القائم.
فإذا كان الأمر كذلك، لم يعد لهذا المثال قيمة بالنسبة إلى الغرض الذي وضع من أجله، أعني من أجل إعادة البناء التاريخية للمجتمعات الغابرة على أساس درجة العقلانية المتحققة فيها، أو من أجل الإرشاد العملي للمجتمع الحاضر. وفي كلتا الحالتين لا يكون هناك غير إجابة واحدة ممكنة ألا وهي الحوار المثالي لم يوجد، ولا يوجد الآن. بناءً عليه تنحصر الانتقادات الموجهة لرؤية هابرماس في تحليل وتفسير العنف المجتمعي بما يلي:
أولاً: بالغ هابرماس في تفاؤله بشأن إمكانية الوصول إلى إجماع عقلاني في جميع الحالات، حيث تجاهل تعقيدات الواقع الاجتماعي وتداخل المصالح المتضاربة والقوى غير العقلانية التي قد تعيق الحوار الفعّال. كما افترض هابرماس وجود فضاء عام مثالي يتم فيه التواصل بحرية وعقلانية، لكن هذا الفضاء قد لا يكون موجوداً دائماً في الواقع، حيث قد تهيمن قوى السلطة ووسائل الإعلام على النقاش العام وتعيق الوصول إلى تفاهم حقيقي.
ثانياً: أهمل هابرماس دور السلطة والصراع الطبقي في تشكيل العلاقات الاجتماعية (خاصة الرؤية الماركسية)، حيث ركز بشكل كبير على التواصل اللغوي، بينما قلل من أهمية العوامل الاقتصادية والسياسية التي تؤثر في توزيع القوة والموارد، حيث يؤدي التركيز على الحوار العقلاني التواصلي إلى إخفاء التفاوتات الحقيقية في السلطة بين الأطراف المتفاعلة، ما يعيق تحقيق العدالة والمساواة.

ثالثاً: يعتبر تطبيق نظرية الفعل التواصلي في الواقع العملي أمراً صعباً للغاية، حيث يتطلب ذلك وجود أفراد قادرين على التواصل بعقلانية واحترام متبادل في ما بينهم، بالإضافة إلى وجود مؤسسات ديمقراطية تضمن حرية التعبير والمشاركة، ففي ظل وجود انقسامات حادة وصراعات عنيفة، قد يكون من الصعب إقناع الأطراف المتنازعة بالجلوس إلى طاولة الحوار والانخراط في نقاش عقلاني.
رابعاً: تأثرت رؤية هابرماس إلى حدٍ كبيرٍ بالتقاليد الفكرية الغربية، ما جعلها غير قابلة للتطبيق في ثقافات أخرى ذات أنماط تواصل مختلفة (مثل ثقافات المجتمعات النامية). وقد يؤدي هذا التركيز المفرط على العقلانية التواصلية إلى تهميش أشكال أخرى من التواصل، مثل: التواصل غير اللفظي، والتعبيرات الثقافية المختلفة.
خامساً: ركز هابرماس بشكل أساسي على العنف المباشر، بينما أهمل مفهوم “العنف البنيوي” المتجذر في أشكال العنف الكامنة في البنى الاجتماعية والاقتصادية، مثل: الفقر، والتهميش، والتمييز. فقد أدى ذلك إلى تجاهل الحاجة الملحة إلى تغييرات جذرية في البنى الاجتماعية والاقتصادية لمعالجة الجذور الأولية للعنف والصراع الاجتماعي.
بناءً على ما تقدم نتساءل كيف يمكن لهابرماس من خلال أسس العقلانية التواصلية ذات الطابع الرمزي أن تجفف منبع العنف المجتمعي وهي غارقة في مثاليتها وطوباويتها بشكل يؤدي إلى انفصالها عمّا يجري بالواقع الاجتماعي. وعلى الرغم من هذه الانتقادات، لا يمكن إنكار أهمية مساهمات هابرماس في فهمنا للعلاقة بين التواصل والعنف. فقد قدمت نظريته أداة قيمة لتحليل الخطاب العام وتعزيز الحوار العقلاني والتواصلي، لكن يجب أن نأخذ في الاعتبار أيضاً القيود والتحديات التي تواجه تطبيق هذه النظرية في الواقع العملي، فمن الضروري أن نكمل رؤية هابرماس بنظريات سوسيولوجية أخرى تركز على دور السلطة والصراع الطبقي والعوامل الثقافية والاقتصادية في تشكيل ديناميكيات العنف والصراع الاجتماعي لتكوين رؤية تكاملية حول مشكلة العنف المجتمعي مثل نظرية: فلفريدو باريتو، والف داهرندورف، لويس كوزر، راندال كولينز.
صراع لأجل الاعتراف
يقول أكسل هونيث في تفسير لمشكلة العنف المجتمعي “المجتمع الجيد هو المجتمع الذي يسمح لأفراده من خلال توفير الظروف الثقافية والاقتصادية والاجتماعية بتحقيق ذواتهم واستقلاليتهم. كما أنه المجتمع الذي يسمح لأفراده بتحقيق أحلامهم دون المرور من تجربة الاحتقار أو الإقصاء. أو بعبارة أخرى جامعة، فالمجتمع الجيد هو الذي يضمن لأفراده شروط حياة جيدة.”
قدم الفيلسوف الألماني المعاصر أكسل هونيث (1949) من خلال نظريته حول “الصراع من أجل الاعتراف” إطاراً فلسفياً، سوسيولوجياً، عميقاً لفهم جذور العنف في المجتمعات المعاصرة بدلاً من التركيز على العوامل الاقتصادية، أو السياسية التقليدية، حيث دعا هونيث إلى تفسير ممارسات العنف كنتيجة مباشرة لعدم الاعتراف بالآخر. بمعنى آخر، يذهب هونيث إلى أن الدافع الرئيسي للعنف والصراعات الاجتماعية ليس فقط بسبب غياب العدالة الاجتماعية في توزيع الموارد المادية كما ادّعت الماركسية، بل أيضاً بسبب النضال من أجل الحصول على الاعتراف الاجتماعي بأشكاله المختلفة.
بذلك، تحتل مقولة الصراع من أجل الاعتراف منزلة أساسية في الحراك الاجتماعي والسياسي، فمفهوم الاعتراف ليس مفهوماً نظرياً فحسب، بل مفهوم عضوي يتطلب سياسة عملية متعددة قائمة على تفعيل مفاهيم المواطنة والعدل والمساواة والديمقراطية، والتقدير، والاحترام، والهوية. كما أن تشكّل الهوية الذاتية يتعلق تعلقاً جوهرياً بهذا المفهوم، وكذلك النضال في وجه الهيمنة والقهر والفقر والاستبعاد والبطالة واحتقار المرأة وإذلالها.
يعتقد هونيث أن الإنسان كائن اجتماعي يبحث عن الاعتراف من الآخرين، وهذا الاعتراف يأتي في أشكال مختلفة، كأن يتم الاعتراف بكرامتنا، بقدراتنا، أو حتى بوجودنا بحد ذاته. وعندما يشعر الفرد بأن الآخرين ينكرون اعترافهم به، أو يحطون من قدره، فإنه قد يلجأ إلى العنف كوسيلة للدفاع عن ذاته أو لإجبار الآخرين على الاعتراف به. ويعرّف هونيث الاعتراف بأنه “الاحترام المتبادل للمكانة المتساوية والفريدة للآخرين.”
ويتكوّن الاعتراف – حسب هونيث – من ثلاثة أشكال أو نماذج معيارية متميزة للاعتراف هي: الحب، الحق (القانون)، التضامن، يستطيع أفراد المجتمع من خلالها تحقيق ذواتهم والاعتراف بها:

أولا الحب: إن الحب هو الصورة الأولية للاعتراف، إذ أنه يربط الفرد بجماعة محددة وخاصة الأسرة التي تمكنه من تحقيق مقصد أساسي يتمثل بالثقة في النفس.
ثانيا الحق (القانون): أما الحق فهو ذو طابع قانوني وسياسي، حيث يتم الاعتراف بالإنسان كذات حاملة لحقوق ما، ولهذا الاعتراف أهمية كبيرة لاكتساب ما يسمى احترام الذات.
ثالثا التضامن: فهو يحيلنا إلى الصورة الأكثر اكتمالاً من العلاقة العملية بين الذوات وهذا لتحقيق مقصد أساسي يتمثل في إقامة علاقة دائمة بين أفراد المجتمع، حيث يتمكن الفرد أن يتأكد أنه يتمتع بمجموعة من المؤهلات والقدرات التي تسمح له بالانسجام الإيجابي مع وضعه الاجتماعي، فيحقق ما يسمى بتقدير الذات.
بذلك تكون هذه الأشكال الثلاثة للاعتراف أي الحب الذي يحقق الثقة بالنفس، والحق الذي يحقق احترام الذات، وأخيراً التضامن وهو أساس تقدير الذات. وإن أشكال الاعتراف هذه تحدد من الناحية الأخلاقية التطلعات الأساسية المشروعة داخل نسيج العلاقات الاجتماعية، وتقاس أخلاقية المجتمع حسب هونيث بمدى إمكانية ضمان شروط الاعتراف المتبادل بين الأفراد.
غير أن تحقيق هذا الاعتراف لا يمكن أن يتحقق إلا ضمن النزاعات الاجتماعية ولهذا يلعب مفهوم النزاع أو الصراع دوراً أساسياً في حركة التطور الاجتماعي، لأن مسببات وعوامل النزاعات والصراعات الاجتماعية ما زالت قائمة ولم يتم تجاوزها، وهذا يظهر بجلاء من خلال شعور الأفراد والجماعات ووعيهم بالظلم أو بما يسمى الاحتقار أو الازدراء الاجتماعي المسلط عليهم.
يعتقد هونيث أنه عندما يقرر الأفراد الانخراط في الصراعات الاجتماعية والسياسية لتغيير الأوضاع المعيشة القائمة التي تكرس تجارب الاحتقار الاجتماعي، وهي تقوم على ثلاثة أشكال: يتمثل الأول في الازدراء أو الاحتقار على المستوى الجسدي عبر التعذيب أو الاغتصاب ما يشعر الفرد الضحية بالذل والخضوع لإرادة الغير وتبعيته لهم، حيث تؤدي هذه التجربة إلى فقدان الثقة بالنفس وفي الآخرين.
أما الثاني فإنه ينحصر عندما يحرم فرد مّا من حقوقه المشروعة لأن ذلك سيؤدي ضمنياً إلى أن المجتمع لا يتعرف بنفس درجة المسؤولية التي يعترف بها لأعضاء المجتمع الآخرين. وينحصر الشكل الثالث والأخير على المستوى القيمي، حيث يرى هونيث أن الحكم على القيمة الاجتماعية لبعض الأفراد بصورة سلبية والتي لا تليق بمقامهم الاجتماعي والأخلاقي، فهذا الشكل من الازدراء يتم على المستوى التقييمي والمعياري وله علاقة مباشرة بكرامة الغير وتقديرهم الاجتماعي داخل الأفق الثقافي للمجتمع
يرى هونيث أن المجتمعات المعاصرة تشهد انتشاراً واسعاً لمجتمعات الاحتقار (الازدراء)، حيث يتم تهميش فئات كبيرة من المجتمع وحرمانها من الاعتراف الكامل. ويربط هونيث بين العنف الرمزي (كالتمييز والتحقير) والعنف المادي. فالأول يمهد الطريق للثاني، حيث أن الشعور الدائم بالإهانة والظلم قد يدفع الأفراد إلى اللجوء إلى العنف المادي للدفاع عن أنفسهم.
ويذهب هونيث إلى أن الحل الأمثل للحد من العنف في المجتمعات المعاصرة يكمن في بناء مجتمعات تقوم على مبادئ المواطنة، والمساواة، والعدالة، حيث يتم الاعتراف بكرامة كل فرد بصرف النظر عن خلفيته أو هويته. بالإضافة إلى ذلك يجب تشجيع الحوار والتفاهم بين مختلف الفئات الاجتماعية، من أجل بناء علاقات قائمة على الاحترام المتبادل. كما يجب تغيير المؤسسات الاجتماعية القائمة وبالأخص المؤسسة التعليمية، والتربوية، والسياسية لجعلها أكثر عدالةً ومساواةً واعترافاً بالآخر.
خلاصة القول لم يكتف هونيث بتحليل نماذج الاعتراف، ولا بوصف أشكال عدم الاعتراف، إنما حاول أن يقدم بديلاً فلسفياً يستند على مثال الانعتاق ويشكل أفقاً للفلسفة الاجتماعية. وأطروحته الأساسية في ذلك هي أن الصراع من أجل الاعتراف يشكل قوة أخلاقية تعزي وتنمي تطور وتقدم المجتمع. لماذا؟ لأن تجربة الإذلال تشكل منبعاً للوعي، ومصدراً لمختلف حركات المقاومة الاجتماعية والانتفاضات الجماعية لتحقيق العدل والمساواة والاعتراف بالآخر. بذلك يعتبر مشروع أكسل هونيث مشروعا فلسفيا يهدف إلى تأسيس نظرية اجتماعية جديدة، بغرض تجديد النظرية النقدية حتى تتلاءم مع التطورات التاريخية الجديدة، وتستجيب للتطلعات الإنسانية الحالية.
وهكذا قدّم هونيث نظرية موضوعية لفهم جذور العنف في المجتمعات المعاصرة من خلال تركيزه على أهمية الاعتراف، حيث يمكننا تطوير إستراتيجيات اجتماعية أكثر فاعلية للحد من العنف وبناء مجتمعات أكثر سلاماً وأمناً من خلال ترسيخ مفاهيم المواطنة والديمقراطية التي تعتبر السبيل الحقيقي للاعتراف والتعايش مع الآخرين.
وفي النهاية نجد أن هونيث أشاد بنظرية أستاذه هابرماس التي دفعت بالنظرية النقدية إلى الأمام وتقديمه لنظرية تُعرف بالتواصل أو الفعل التواصلي، ومقاربته التي تسمح باكتشاف البُعد الاجتماعي والعلاقات الجديدة التي أحدثها بين النظرية والممارسة، وهو ما أدى إلى ابتعاده عن أسلافه، وخاصة فيما كتبه أدورنو وهوركهايمر في كتابهما “جدل التنوير” ولم يكتف هابرماس بالنقد فقط كما فعل أسلافه، وإنما قدم نظرية الفعل التواصلي التي تعتبر في نظر هونيث، بمثابة منعطف حاسم في تاريخ النظرية النقدية أو مدرسة فرانكفورت. غير أنه بقى متحفظاً على اختزال هابرماس للحياة الاجتماعية إلى البعد اللغوي والتمركز حول اللغة الذي قد يحجب عنها حقيقة التفاعلات المجتمعية ويؤدي إلى عدم القدرة على إدراك التجارب الاجتماعية والأخلاقية المرتبطة بأشكال الظلم والاحتقار وعدم الاعتراف بالأفراد والجماعات.
نقد تفسير هونيث لمشكلة العنف المجتمعي

على الرغم من أهمية نظرية هونيث وتأثيرها الكبير في الفلسفة الاجتماعية والسياسية المعاصرة، إلا أنها واجهت العديد من الانتقادات، حيث يرى العديد من النقاد أن هونيث بالغ في أهمية الاعتراف كدافع وحيد للصراعات الاجتماعية، كما أنه تجاهل عوامل أخرى مهمة كالمصالح الاقتصادية، والقوة السياسية. ويرون أن الصراع لا يقتصر فقط على الجوانب الرمزية والثقافية، بل يشمل أيضاً جوانب مادية ومؤسساتية. كما نأخذ على هونيث أنه لم يقدم لنا تعريفاً واضحاً ومحدداً عن مفهوم الإهانة الاجتماعية (الازدراء الاجتماعي) الذي يؤدي إلى العنف المجتمعي (الصراع الاجتماعي) من أجل الاعتراف، ما جعل من الصعب تحديد ما يُعتبر إهانة وما لا يعتبر كذلك.
هذا الغموض أدى إلى تفسيرات ذاتية ومختلفة للإهانة، ما أضعف القدرة التحليلية والتفسيرية لنظريته عموماً. كما توجد صعوبة بالغة في التمييز بشكل واضح بين أشكال الاعتراف الثلاثة التي ذكرها هونيث (الحب، الحق “القانون”، التضامن)، حيث قد تتداخل هذه الأشكال وتتفاعل مع بعضها البعض في الواقع الاجتماعي هذا من جانب. ومن جانب آخر نجد أن هونيث تناول مفهوم العنف الرمزي كشكل من أشكال إنكار الاعتراف، إلا أنه تجاهل نسبياً العنف المادي المباشر، كالعنف الجسدي، والعنف الممنهج. ويرى البعض أن التركيز على العنف الرمزي والثقافي قد يؤدي إلى إغفال أهمية العنف المادي في الصراعات الاجتماعية.
وأخيراً يذهب بعض النقاد إلى أن نظرية هونيث ذات طابع مثالي، حيث تفترض وجود إمكانية لتحقيق اعتراف متبادل كامل بين جميع الأفراد والجماعات في المجتمع، يرون أن هذا الافتراض يتجاهل واقع الصراعات المستمرة والتنافس على الموارد، والقوة، والسلطة في المجتمعات الإنسانية المعاصرة كما عبّر عنها عالم الاجتماع الأميركي المعاصر راندال كولينز، حيث تقوم نظرية الصراع عنده على افتراض هام مؤداه، توجد مجموعة معينة من السلع Goods التي تتمثل في القوة والهيمنة، وما يرتبط بها من عملية توزيع الثروة، حيث يسعى الناس دائماً للحصول عليها في كل المجتمعات تحقيقاً لمصالحهم وأهدافهم الذاتية. ففي العالم قد تكون هذه السلع موزعة بصورة غير عادلة ومتساوية، ما يزيد من عملية الطموح وزيادة سعيهم في الحصول عليها مستقبلاً، الأمر الذي ينتج عملية الصراع الدائمة والمضادة.






















